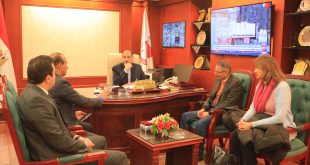انطلاقًا من استخدام التكنيك السردي في مخاطبة القارئ وإشراكه في المشروع الأدبي، أدمج هشام عيد خطين زمنيين متخيلين جعلهما ركيزتين أسس بهما سبيكته الأدبية «كمار».
في تقاطع زمني بين عصر الرواية المتخيل الأساسي القريب حقبة “الخُط” وأحوالها في صعيد مصر، والزمن المتخيل الثاني البعيد إبان زوال العصر العباسي وما جرى فيه من أحداث جسيمة، يتداخل فيما سبق انزياح المكانين رفقة الزمانين المذكورين تبعًا للزوم بعضيهما عن بعض.

ثم انتقى المؤلف محورًا ديناميكيًا للقصة ضاربًا في جذور التاريخ، حمَّال لما لا تنتهي به الروايات من ترميز وإسقاطات قديما وحديثا، خاصة على المستوى الشعبي عربيا وإسلاميا، تجلى ذلك في شخصية الرواية الرئيسية، ذلك الشاذ الذي لطم به المؤلف وجه التاريخ، حتى جعل من وجهه عبرة لكل مخدوع في براءته وعدم انحيازه الظاهري إثر كل بغي أو طغيان، هو ذلك النموذج القديم الحديث، الذي جعل منه هشام عيد مقصلة قطع بها هذا الصمت الموحش الذي تذَّرع به التاريخ كلما أردنا محاكمته.
ما فعله هشام عيد في هذه الرواية أنه غاص في دركات التاريخ ليصدح من القاع ويعلنها مدوية «انتصر التاريخ للعهر في نهاية المدى».
هي بجدارة رواية الثنائيات الجائرة على مر التاريخ، بين السادة والعبيد، والقوة والضعف، الثراء والفقر، إنها مُلَخصةٌ؛ رواية البغي والطغيان، تشكل مسرحا مصغرا لتاريخ الدنيا، الكثير من الطمع، الكثير من الخيانة، الكثير من الظلم، الكثير من الموت، القليل القليل من الآدمية القليل القليل من الحب، القليل القليل من الوفاء.
رسمت شخصيات العمل بإتقان، وقدرة لغوية وبلاغية، مع تأثيث الرواية بالكثير من نثار الحكمة والإسقاطات التاريخية الساخطة على أحداث التاريخ المخزية عمومًا وانتقاد ممارسات أواخر ملوك وأمراء الدولة العباسية، تلك النثارات الوافرة المبثوثة في أنحاء الرواية، جعلت منها منهلًا أدبيًا ثريًا بالدرر المعرفية والجمالية، كقوله عن لذة الشهوة وإشباع الغرائز في وصفه مشهد افتراس الثعبان لفراخ اليمام: «تلك لذة يطيع من أجلها كل آمر» كذلك قوله عن خنوع الكثرة الكاثرة من الناس إلى الظلم: «الناس تكمن كالجرذان تيسيرا على المغتصب»، وفي موضع آخر: «حتى الطغاة لا يتقنون الحرية فيبحثون عن طاغية أكبر لينقادوا تحت لوائه» وكثير من الإسقاطات التاريخية مثالا لا حصرا في صفحات (٦٥، ٦٦، ٦٧).
على أنه كان من اليسير علينا الوقوف على ملامح وأطر عامة لهذا النص المسبوك بفنية خاصة وطرح لغوي بات مميزًا به هشام عيد في أعماله السابقة، ومن تلك الملامح العامة للرواية:
جرأة الطرح ورصد القبح برشقات لغوية غاية في الإصابة. ومنها: اقتناص الفسلفة من المشاهد والأحداث كلما أثمر الحدث تفلسفًا وحكمة، مثل مشهد التهام الثعبان فراخ اليمام وغيره كثير. ومنها: الإغراق في الإسقاطات الاجتماعية الطبقية والسياسية كأن يقول مثلا:
«الناس في في بلدتنا يتميزون بالقناعة والرضا؛ لو قطع الحاكم لهم أذنًا لفكروا على الفور في حمد الرب أنه أبقى لهم الثانية»…
ومنها: الدق على نقيصة المجتمع المهلكة وهي التصفيق للباطل، نجد ذلك مثلا في حوار فايق مع زوجة الأخ عابد الذي مات كمدًا لهضم حقه، وموقف فخري وزمرة فايق…
ومنها: الإيحاءات الجنسية على طول الخط السردي سيما وموضوع الرواية معلوم…
ومنها: التساؤلات المباغتة بين الفينة والأخرى، كما يستوقفنا ليسأل: “أليس هذا تاريخًا أيضًا يا صاحب التاريخ”.
منها كذلك أنها رواية كثير أمواتها، فعلى الأغلب يموت شخص أو اكثر في كل فصل. على أنها اشتملت تعبيرات جمالية مدهشة أكسبت السرد لذة قُرَّائية كبيرة، من تلك التشبيهات والصور: (البطيخة التي لم تنشق اهترأت من دعك الأكف- دود وحب وحَبٌّ شفيق- زرعت الفراغ في قلوب الرجال- أخرس التاريخ ذكراها- اغتصبه الشك.
كذلك استحث الإنسان بداخلنا على البكاء كرهًا حين صور مشهد قتل الحداد لابنه الصغير بعد عمله بخيانة زوجته وقتلها: «أظن أن الصغير وهو يعدو كان يبحث عنه هو، عن أبيه».
أي مرارة وأي غصة تلك التي القيتها بقلوبنا يا هشام؟!
وحين يسير الصراع الداخلي لبطل النص ويتنامى إلى حد كفره بكل ما عرف، وحرق المصحف والإنجيل وانتفاضته الكبرى واعتياده القتل، انتهاء بقتل أهم أسباب استذئابه؛ مدرس الفرنساوي، لم يترك الشاذ المتحول دماء الذئب تسري في دماء ابن البواب الحر فقتله، نائيًا بذلك عن إثم استذئاب فرد واحد، وما أكثر المستذئبين الضحايا.
وفي الأخير يمكننا، اعتمادًا على ما نعايشه من مهازل أخلاقية وكوارث اجتماعية وإخفاقات سياسية تحيط بنا من كل تُجاه، الإقرار بأريحية بتضامننا مع صوت الرواية الصارخ؛ أن الحياة عاهر يستوعب فرجها العالم بكل أنذاله وأوحاله. اللعنة منذ الآن على كل ذكرىٰ وكل مُقدَّس، أن التاريخ انتصر للعهر.. على الأقل حتى الآن.
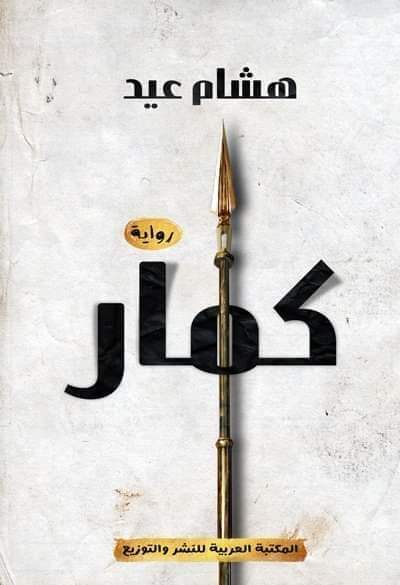
 الخبر الثقافي موقع يهتم بكافة النواحي الثقاقية بمختلف مجالاتها وتغطية الأخبار الفنية .
الخبر الثقافي موقع يهتم بكافة النواحي الثقاقية بمختلف مجالاتها وتغطية الأخبار الفنية .