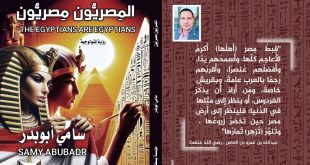تأتي رواية (أفندينا) للكاتب محسن الغمري لتثير الكثير من الأسئلة، ولكن بعض هذه الأسئلة يرتبط بالكتابة الروائية التاريخية في العقود الأخيرة التي انطوت على مفهوم خاص، لا يأخذ من الماضي بقدر ما يعطي محيلا هذا الماضي إلى حركة دائمة، لإقامة حوار له خصوصية ينطلق من مناح فكرية معاصرة. ويرتبط بهذا النمط الكتابي تغيير في طبيعة الدوافع، ووقوفها وتوزعها بين عقد المشابهة بطريقة إسقاطية بين الماضي والحاضر، أو تعاظمها على هذا المسلك، حين تجعل الآني والمعاصر رافدا للماضي، فلا يظل هذا الماضي ثابتا في ظل سردية وحيدة مشدودة للصمت والثبات والامتداد.
فالرواية تجعلنا نعيد التساؤل والنظر والمقاربة والمراجعة حول مرحلة زمنية مهمة من تاريخ مصر، وربما تكون هذه المرحلة الزمنية الممتدة من بداية القرن التاسع عشر إلى منتصف القرن العشرين- بالرغم من أن الرواية تقف عند نهاية عهد عباس حلمي- هي المرحلة الأكثر تأثيرا في تشكيل الوعي، وفي تنميط العادات والتقاليد التي يتمّ تداولها في اللحظات الآنية بالرغم من انتقالها من بيئات بعيدة، مثل الشارة السوداء حول الذراع وارتباطها بمقدونيا، أو تحريم بعض الأطعمة والحلويات بعد موت أحد من الأسرة، وارتباط القهوة بفعل الموت.
في إمداد القارئ بالسياقات وتولد هذه السياقات بوعيها اللافت، وبداية تشكل هوية منفتحة على الآخر بعيدا عن الدين أو العرق أو الجنس انطلاقا من رؤية وتوجيه محمد علي، تشكل الرواية بالإضافة إلى ذلك خطاب مراجعة حول مرحلة زمنية ترتبط بشخصية عباس حلمي، واعتمدت في تحقيق ذلك على مجموعة من الآليات الفنية الخاصة ببنية الرواية وتشكيل السرد. أهمها اعتمادها على كتابة المذكرات (المخطوط) الذي يعثر عليه بطلان يمثلان اللحظة الآنية، ويمثلان –في ظل حضور المخطوط الذي يعيدان نسخه- سياقا للمشابهة والمقارنة في معاينة التحولات والتباينات بين الماضي والحاضر، وفي ثبات الأنساق التي تنتهجها الدول الكبرى في وجود أجندات طويلة المدى للتطويق والسيطرة مطروحة للتحقيق، خاصة حين يتعلق الأمر بمكان حيوي يكتسب حضوره التاريخي من مكانه الجغرافي.
لا يخالف الكاتب آلية التأريخ الموجودة لدى الجبرتي في وضع النسق القائم على الزمن أو السنة التي يرتبط بها الحدث بوصفها نقطة الانطلاق في خطابه التاريخي، بالرغم من وجود فروق جوهرية بين نص االجبرتي في خطاب التاريخ، ونص (القولي) في خطاب الرواية، بداية من الانتماء في زاوية الرصد، فالجبرتي مصري منفتح على العالم بكل فئاته وطبقاته، والقولي ينتمي إلى بلدة محمد علي، ومهموم بالرسمي لوضعه الوظيفي بوصفه كاتب بلاط الذي يؤثر بالضرورة في زاوية رصده ورؤيته للأشياء والحوادث.
بنية الإيهام (المذكرات والمخطوط)
يتشكل خطاب القولي من خلال اعتماده على المذكرات (المخطوط) التي تمت كتابتها بعد نهاية الحدث، وكتابتها بعد العودة إلى قريته، وهي على هذا النحو تؤدي إلى وجود شيئين: الأول يتمثل في قراءة الأحداث وتأويلها، فالمذكرات لا تقدم وعيا لحظيا آنيا، وإنما تقدم للقارئ وعيين، وعي لحظة المرور بالحدث، ووعي خاص بلحظة الكتابة، وهذا الوعي الأخير لا يخلو من التأويل، ومن ثم لا تخلو الكتابة في نص المخطوط من إضاءات معرفية مرتبطة بمقاربة الحوادث بشكل مختلف، ومن الهمّ التأويلي في نمطي التبرير والدفاع اللذين تنتهجهما في معاينة سلوك وتوجهات عباس حلمي المغايرة لتوجه الجدّ محمد علي.
وهناك –أيضا- نتيجة لهذه البنية الإيهامية الخاصة بالمذكرات مساحة كبيرة من الاستباقات والنبوءات، وهذا يجعلها منفتحة على التشويق، مثل قول الشيخ الضرير(حسن الفناجيلي) للقولي صاحب المخطوط أو المذكرات حين ذهب إليه بنفحة مالية أرسلها إليه عباس حلمي لتحقق نبوءة حكمه (حزين أنا على صاحبك، فهو لا يعلم أنه يسعى إلى نهايته)، أو في حديثه عند ميلاد الأميرة زينب وإشارته إلى دورها لحظة ميلادها في تشكيل الاتجاه المقابل والمضاد لعباس حلمي، من خلال قوله (لم يخطر ببال بشر أن هذه المولودة الصغيرة التي لا حول لها ولا قوة سيكون لها في الغد حول وقوة للغاية في حياة ابن أخيها الأمير عباس حلمي).
يتمثل الشيء الآخر في انفتاحه على مساحات التأويل الذي يقدمه صاحب المذكرات، وذلك من خلال الملحوظات التي يقيدها داخل المخطوط، وهذه الملحوظات في كثير من الأحيان وثيقة الصلة بالوعي، لأن الملحوظة في سياق الرواية تستخدم على أنها جزئية من جزئيات التوجيه نحو الخطاب الذي تؤسسه، ونحو الخطاب الذي تحاول تفكيكه. وقد كفلت هذه المذكرات المرتبطة بالإيهام والموزعة إلى أعوام للكاتب في تأسيس خطابه الروائي الانتقال من موضوع إلى موضوع آخر دون أن يكون هناك ثمة رابط على المستوى الواقعي.
يتأسس مع الحرية السابقة حرية اختيار الحدث، ووضعه في بؤرة الاهتمام دون غيره، وهذا يدخلنا وجها لوجه مع فعل التحبيك المشدود للتوجيه السردي، فالكاتب يختار الأحداث انطلاقا من توجيهه السردي، وبناء خطابه التاريخي التخييلي، فهو يختار الأحداث التي تسهم في بناء خطابه التأويلي القائم على المراجعة للخطاب التاريخي المتفق عليه، أو يمثل – على الأقل-خطابا ذا سردية حققت نوعا من الشيوع والانتشار. يتمثل ذلك في اختياره للحوادث الكاشفة من وقت مبكر بداية من لحظة ميلاد عباس حلمي لتشكيل التنازعات والتباينات المتقابلة الفاعلة في توجيه الحدث وصناعة التاريخ، مثل الخصام بين عمته نازلي وأمه، أو رؤية عمه إبراهيم الخاصة له، وبداية تكوين نسق مناوئ له من البداية حتى قبل أن يصل إلى الحكم. فهذا التحبيك الخاص بالحوادث المحددة وإهمال غيرها يكشف عن تشكيل خطاب يتوجه نحو غايته التبريرية التي يحاول خلقها في التخييل الروائي.
ثمة جزئية على نحو كبير من الأهمية تتصل بالمذكرات، ففي المذكرات لا ينفصل الذاتي عن العام، والعام في نص الرواية يتجلى من سبيلين: الأولى وجوده بوصفه كاتب بلاط محمد علي، والأخرى تتمثل في وجود زوجته (يلدز) في الحرملك، فوجودها علامة مهمة في الكشف عن تكوّن وتشكيل الاتجاهات المقابلة والرافضة لعباس حلمي، من خلال فاعلية وسيطرة عمته نازلي، ووعي زوجة القولي بالمؤمرات والدسائس التي تحاك ضده.
الخطاب في ظل حركته بين بلاط الحكام والحرملك يظل مشدودا إلى مساحة محددة، يمارس فيها النص الروائي من خلال عمليات الاختيار والتحبيك قدرته في تشكيل سردية المراجعة، ولكن هناك كوة تنفتح على المصريين بداية من دخول جاريته (روبية) إلى بيته الذي عاشت فيه بعد موت زوجته، وانفتاحه على جاره (مسعود) حيث يكشف جزءا من هوية هؤلاء المصريين في انفتاحهم على الآخر المغاير، فهم يحتفون بالغريب أكثر من احتفائهم بنماذجهم وأنفسهم، ربما بسبب ميراثهم الطويل المرتبط بالحاكم الأجنبي.
استناد هذه المذكرات إلى (مخطوط) تمّ العثور عليه في اللحظة الآنية، له دلالته في اكتشاف وجهة نظر مغايرة، ربما ظلت مهمشة وغائبة لفترات طويلة. فاستناد الرواية إلى مخطوط يضع فكرة الإيهام في بؤرة التركيز، لأنها تضع الإطار الأساسي وإن كان متخيلا في إطار رؤية ذاتية لها مشروعيتها وقداستها. فالمخطوط- من خلال هذا الذاتي- يقدم خطابا ضد السائد المتفق عليه، ويؤسس وجهة نظر مختلفة، وغالبا ما تكون وحهة النظر هذه هامشية، ليس لها من الصدارة والاتفاق حولها ما يجعلها سائدة أو شبه مهيمنة. ولكن بقاء هذا المخطوط حيا، يكشف عن مشروعية وقيمة وجوده، وفي ذلك إعادة مقاربة ومراجعة للماضي، فيتحول إلى حالة للحركة وليست للثبات.
فالروائي – في ظل أي كتابة روائية تتوسل بالمخطوط- يعطي لنصه مساحة من الاختلاف، ومساحة من الحرية في التحبيك، ويعطي لخطابه نوعا من القداسة، يمكن أن نطلق عليها قداسة الخطاب الهامشي المنزوي في روايات تاريخية لم توجه السائد العام، تعطي خطابه نوعا من الحرية في تصوير الحادثة من خلال وجهة نظر مغايرة للخطاب السائد المتفق عليه. فالمخطوط سرد يستند إلى المخيلة، وتأتي السنوات المحددة بوصفها محطات أو ركائز للحركة قد تؤدي إلى منح هذا الخطاب القائم على التخييل والتبرير نوعا من المشروعية.
إن هذه الآلية لا تجعل التاريخي دائم الحضور في الآني، وإنما تجعل الآني دائم الحضور في الماضي مؤثرا فيه، بل تجعله يتجلى بشكل مغاير من خلال الانتصار لرؤية معاصرة، تثبت ديمومتها واستمرارها ووجودها في ظل معاينة الماضي بوجوده الهامشي، فينعش هذا الهامشي، ويصبح مساويا للخطاب المتفق عليه. لقد ولدت آلية المخطوط مساحة للتأويل، مساحة لتقديم خطاب مغاير، فهناك خطاب تاريخي عليه شبه اتفاق، ولكن الرواية فيما يخصّ عباس حلمي تقدم من خلال المخطوط المرتبط بخطاب (القولي) وتأويله، خطابا آخر، بداية من الكلمة الدالة (المغدور به) التي شكلت نقطة الانطلاق، وأصبحت محركا ومسيجا للرواية وتحبيكها سواء في مجال اختيار الأحداث الكاشفة، أو في تكوين وتشكيل الشخصيات.
في ظل هيمنة وصدارة خطاب المذكرات المشكل داخل المخطوط، بما يجلبه من هواجس القيمة المختزنة المناوئة للسائد، هناك توجه آخر يتمثل في خطاب معاصر من خلال شخصيتين معاصرتين -السفير الذي حصل على المخطوط لطبيعة عمله وسفرياته، وصديقه الذي شكلت له شخصية عباس حلمي حضورا لافتا من البداية- تقومان بفعلي القراءة والنسخ، وهو تداخل مهم بالرغم من حضوره البسيط في نص الرواية، فقد كان من الضروري في ظل التنبه إلى قيمة وحيوية الآني في رؤية الماضي، وتحريكه أو تقليبه في ظل جدل وجهات نظر مختلفة أن يتمدد هذا الخطاب، ويأخذ مساحة أكثر اتساعا، للكشف عن الجانب المعرفي الخاص بمنطلقات الرؤية.
وفي سياق هذا الحضور المبتسر للخطاب المعاصر تتباين وظائفه، ففي أغلب الأحيان يأتي بوصفه إعلانا عن الوجود، وفي التذكير الدائم للقارئ بأن ما يقومان بتدوينه ونسخه خطاب ماض، ولكنه وثيق الصلة بالحاضر، وإمكانية تكراره، بالإضافة إلى حضور التجاوب والتباين بين الزمنين. لكنه – في أحيان ليست كثيرة- ينبهنا هذا الخطاب إلى ثوابت الدول الكبرى التي تتحرك وفق مصالحها من خلال التنبه الدائم والخطط طويلة المدى حين يرتبط الأمر بالدول ذوات المواقع الحيوية في العالم، فالرواية من خلال هذا الخطاب المعاصر تأخذ النسق الإسقاطي المراقب للحاضر والماضي في آن، خاصة في الجزئيات الخاصة بالأمن القومي، وتأمين منابع النيل بداية من عصر محمد علي.
ولكن هذا الخطاب المعاصر لا يخلو في بعض جزئياته من التحلل من هذا النسق الإسقاطي، ليؤسس وجوده من خلال انشداده إلى قيمة خطاب الرواية التاريخية الجديدة التي لا تنطلق من تقديس التاريخ، أو التعامل معه على أنه نسخة وحيدة، فالتاريخ- وفق نظريات ما بعد الحداثة- نسخ عديدة، ولهذه الفترة سرديات عديدة، ونحن في هذه الرواية أمام سردية جديدة، يتجلى ذلك حين يلتحم هذا الخطاب المعاصر بالخطاب المضاد، وذلك من خلال محاولات التبرير والتفسير والإنكار لكل أشكال الخطاب المتفق عليه. ففي بعض الأحيان يتداخل الخطاب المعاصر مع خطاب الرواية في بعض حوارات السفير مع صديقه لنفي الصورة الجاهزة عن عباس حلمي، فنجدهما يقدمان تأويلا لخطاب الرواية، ويجلّيان اختلافه عن خطاب تاريخي معاصر، لا يذكر فيه عباس حلمي إلا مقرونا بكل ما هو سلبي.
الخطاب المضاد وتغييب الهوية المستقرة
تشكل الرواية من خلال خطابها الخاص بالمخطوط خطابا يمكن أن نطلق عليه خطابا مضادا، أو خطاب مراجعة لما اتفق عليه، أو كان عليه نوع من الإجماع والشيوع. فالقارئ لإسهامات غالبية المؤرخين لتاريخ أسرة محمد علي، سوف يقابله خطاب تنميطي خاص بعباس حلمي، تتشكل حدوده في إطار أحكام جاهزة مستقرة، فعهد أو فترة عباس حلمي في ظل ذلك الخطاب كان عهد تراجع على أكثر من صعيد، وأنه كان عصرا يرتبط بالتخلي عن الأسس التي كونها جدّه، حيث توقفت حركة التقدم والنهضة.
يطالع القارئ لهذا التاريخ الخاص بعباس حلمي أحكاما جاهزة، وجزئيات مستقرة في الكتابة التاريخية عنه، فهناك ديمومة للإشارة إلى أفعاله وسلوكه مع أفراد أسرة ورجال محمد علي، ومحاولة قتل عمته نازلي. ولكن خطاب الرواية المستند إلى الوعي بتقلبات الحكام وطبقته ومرواغاته وإلى كشوفات زوجة القولي (يلدز) لارتباطها بالحرملك وكونها جليسة أمينة هانم الوالدة باشا، في تشكيل الإطار الكاره لعباس حلمي ونموه، لا تسلم بكل هذه الجزئيات المتفق عليها.
فمن خلال الوعي بالحدث والسياقات المحيطة تنتهج الرواية نهجا تبريريا لافتا، ففي جزئية إغضابه لأسرة محمد علي ورجاله، نراها تجعل سلوكه من خلال المقارنة والتركيز على كلمات بعينها شبيها بالخليفة الأموي عمربن عبدالعزيز، وذلك من خلال استناد عباس حلمي إلى تفريق واضح وحاد بين مال محمد علي، ومال بيت المسلمين، لكن أولاد محمد علي وأحفاده ورجاله لا يفرقون. أما محاولة قتل عمته نازلي فالرواية تستحضر خطابا مختلفا أو سردية مغايرة تؤسس لها من خلال انتخاب أحداث سردية وتعطيها نوعا من مشروعية الوجود، فبعد وفاة زوجها الدفتردار القائد القوي ألمحت الرواية إلى ارتباطها بأحد حرّاسها، وأشارت من خلال سرد مؤسس تمت معاينته من القولي إلى طلب أبيها محمد علي من عباس حلمي القيام بقتلها، ولكنه –إمعانا في إسدال خطاب المغايرة- يرفض، لأن في قتلها من وجهة نظره تلويثا لسمعتها.
ولكن الجزئية الأكثر أهمية في الخطاب التاريخي المؤسس والمتفق عليه عن عباس حلمي تتمثل في معاداته للتحديث، ولحركة الترجمة، وإغلاقه لمدرسة الألسن، ونفيه لرفاعة الطهطاوي إلى السودان وآخرين من الأساتذة والمهندسين النابهين، وكذلك إعادته للمبتعثين، بالإضافة إلى تعاليه في تعامله مع الأجانب وقناصل الدول الأجنبية. في تشكيل خطاب مقابل للجزئيات السابقة لا تنتهج الرواية خطابا مضادا في نفي الجزئيات السابقة أو لتجذير التشكيك في مشروعيتها، لكنها مارست بهدوء بنائي ممتد يستند إلى التكوين والتشكيل الخاصين بعباس حلمي نوعا من التوجيه السردي.
تتأسس ملامح هذا التوجيه السردي بداية من ميلاده بالسعودية أثناء حملة أبيه الأولى عليها، وظروف ميلاده التي جعلته مريضا بالصرع، وطبيعة هذا المرض التي جعلته أكثر حدة وابتعادا وأكثر توجسا وريبة. ولكن الجزئية الأكثر أهمية في هذا التوجيه السردي تتمثل في ارتباطه بالشيخ الإحسائي السلفي الذي أثر في رؤيته للآخر المباين، ولغير المسلمين بشكل عام، وانحيازه لأيديولوجيا الدين التي تؤمن لأصحابها يقينا فريدا ومستقرّا.
لقد أصبح عباس حلمي وفق هذا التوجيه السردي ينطلق ويتصرف وفق محدد وسنن أيديولوجي يرتبط بالدين الإسلامي، وذلك من خلال تأثير شيخه الحنبلي السلفي، وارتباطه وصداقته بالوهابيين، فقد رفض وضع شارة الحداد على ذراعه قائلا (تلك بدعة محدثة ليست من الإسلام في شيء). ولكن هذا الانتماء يصبح ذا أثر سلبي إذا ارتبط بتحديد حدود الأمن القومي، فحين جمع جدّه محمد علي كبار رجال دولته للتشاور حول حملته على الشام، قدم عباس حلمي رأيا استوجب توبيخ عمه إبراهيم قائد الحملة، لأنه في بناء رأيه يستند إلى محدد أيديولوجي، يجعله يقف بحدود أمن مصر القومي عند خليج السويس، مبررا ذلك بقوله (ونكفي أنفسنا شرّ القتال، ونتجنب ارتكاب إثم كبير بإراقة المسلم دم أخيه المسلم).
يكشف هذا التوجيه السردي عن تبرير مبطن غير معلن لكل الجزئيات التي أشرنا إليها سابقا، يتجلى ذلك في خطابه بعد الاستيلاء على حمص وانتصار الجيش المصري على الأتراك، ففيه يظهر الانتساب إلى الدين بوصفه إطارا يجمع الجميع مصريين وسوريين، ويتوازى مع ذلك إطلاقه سراح النجديين والوهابيين الذين سجنهم جدّه محمد علي.
يكشف خطاب الرواية عن رؤية مشدودة إلى نسقين متقابلين، يسهمان في تشكيل هويتين، أو -بشكل قد يكون أكثر دقة- في تشكيل توجهين، يرتبط الأول منهما بالاحتياج للآخر في جزئيات تفرده وإنجازه، بينما يتوقف التوجه الأخير عند حدود الذات مستندا إلى يقينه بذاته والاكتفاء بما لديها. ففي خطاب الرواية عن محمد علي بشكل خاص، ومحاولته تأسيس دولة ذات هوية لها حدود آمنة، بالإضافة إلى الإشارات الخاصة بتأسيس أول مجلس نيابي سنة 1829م، وأسماه مجلس المشورة، نستطيع أن نقارن بين توجه الجد وتوجه الحفيد عباس حلمي، فمحمد علي كان في تأسيسه لحكمه مصرّا على الانفتاح على الآخر، دون نظر إلى دين أو عرق أو جنس، وهذا التوجه جعله يعتمد على أناس متفردين في مجالاتهم العلمية أو العسكرية.
أما مع عباس حلمي فقد شُكّل في الرواية من خلال توجيه سردي خاص، جعله حاملا لتوجهات أيديولوجية مغايرة، فمع هذا الخطاب الخاص بعباس حلمي يجد القارئ نفسه أمام توجه ديني ينتصر لما هو إسلامي، بوصفه هوية تتعاظم على الهوية القطرية، فالهوية مع محمد علي مصرية قطرية محددة تلمّ شتات الأجناس والأديان، ولكنها مع عباس إسلامية تتعاظم على التكوين القطري، ففي خطاب تنصيبه واليا يقول (إذا كان عليّ أن يحكمني أحد فأنا أفضل أن أكون خاضعا لأمير وخليفة المؤمنين ليحكمني على أن يحكمني هؤلاء الصليبيون الذين أكرههم).
هذا التوجه المباين لتوجه الجدّ محمد علي توجه مشدود للانغلاق، والاكتفاء بما لدى الذات، لأن أصحاب هذا الاتجاه يقدرون ويثمنون ما يملكون ويكتفون به. وفي إطار ذلك الفهم يمكن تفسير تسريحه لكل الجنسيات غير المسلمة، وتعامله بغلظة مع قناصل الدول الأجنبية، وإغلاقه لمدرسة الألسن، وإعادته للمبتعثين، فقد قال له الشيخ الإحسائي الحنبلي السلفي (إن التعلم في بلاد المشركين يأتي في معظم الأحوال معه مردود سيء على كل من تعلّم علمهم وسلك سلوكهم). وقد أدى ذلك التوجه إلى وجود زحزحة بعيدا عن الأسس التي أقرّها محمد علي سلوكا ناجعا يجمع المختلف والمغاير تحت مظلة واحدة تشكل هوية وطنية قطرية، لتتحول إلى هوية دينية، تأخذ على الجد محمد علي إفراطه في مديح كلوت بك لعلاجه للمصريين في أزمة الكوليرا، وذلك في قوله (كيف تسنّى لجدي أن ينسب فضل شفاء الناس والتخلص من الوباء لهذا الفرنسي).
وإذا كانت الرواية تشير بخطابها إلى توجهين كاشفين عن هوية منفتحة على الآخر والإفادة منه، وهوية محتمية بما لديها مكتفية به، فإنها في الوقت ذاته تؤسس من خلال جدل التشابه والاختلاف بين خطابها وخطاب الجبرتي التاريخي حضورا لافتا، فثمة تشابه في الأطر العامة يظل حاضرا للإشارة إلى خطاب الجبرتي التاريخي، وثمة تباين تتشكل حدوده من حدود الموقعية، وحدود الوظيفة المعرفية، وطبيعة الانتماء والأصول لصاحب كل خطاب.
يأتي الجبرتي في نص الرواية ومن خلال خطاب القولي، بوصفه صاحب أثر فاعل ومدرسة فكرية تنتصر للهوية المصرية أمام تكتل الأتراك والدول الأوربية في محاربة نزوع محمد علي نحو تأسيس دولة قوية ذات سيادة، بل يصبح في بعض الجزئيات قرينا ووجها للمثقف الحقيقي الذي يحافظ على حيادية صوته ومشروعه، ولهذا ظلت علاقته بالسلطة متوترة شدا وجذبا. يتجلى ذلك حين نعاين آلية تعامل السلطة ممثلة في محمد علي معه، فالأخير كان حريصا على إرسال رسائل تحذيرية مبطنة مثل (إن لم تكن معنا فأنت علينا)، أو ينعته في حواره مع القولي (بالعبد الأسود).
فالجبرتي في هذه الرواية وجه ورمز للمثقف الحقيقي، لا يكتب إلا ما يؤمن به ولو ألحّ محمد علي في الطلب لتغيير خطابه، وقد أدى ذلك إلى تفاقم علاقته بالسلطة في عهد محمد علي الذي أوحي للدفتردار بتأديبه والتعامل معه، وتسبب ذلك في مقتل ابنه خليل الجبرتي. ويمكن أن نتوقف في إطار تلك الجزئية للإشارة إلى المغايرة بين خطاب الجبرتي وخطاب القولي، نظرا لانتمائه إلى مسقط رأس محمد على، ومدى أثر ذلك في تبريره ومقاربته لبعض الحوادث.
ربما تتجلى المغايرة بين الخطابين بداية من طبيعة توجه كل خطاب، فتوجه الجبرتي ينطلق نحو الحكام ونحو الشعب بكل فئاته، ولكن توجه القولي يرتبط بالحكام وبالذات، في الأول انفتاح على الحياة بكل أنساقها وتجلياتها، وفي الأخير تركيز على الحاكم نظرا لمعاينته وقربه من الأحداث. الفارق هنا يتمثل ويتجلى في حدود الموقعية، وفي وجهة النظر والانتماء بالإضافة إلى زمن الكتابة، فالأول مرهون انطلاقا من فكرة المتابعة بالتسجيل، والأخير لارتباطه بالكتابة بعد المرور بالحدث بالتفسير والتأويل.
فقد أثرت فكرة انتماء القولي على رؤيته لخلاف الجبرتي مع محمد علي، فيبرر بداية الخلاف بإلغاء محمد علي لنظام الالتزام الذي كان يستفيد منه الجبرتي. ولكن الحادثة الأهم في مساحة الاختلاف هي حادثة مقتل خليل الجبرتي، فالقولي بالرغم من شكوكه في تدبير محمد علي لمقتله فإنه ينتصر لوجهة نظر محمد علي، فيستند إلى الرواية الرسمية للسلطة ويعضدها، فقد أشارت هذه الرواية إلى أن الشرطة أوقفته للتفتيش عن السرقة، وضربوه حتى الموت، لكن القولي يتبنى وجهة النظر الخاصة بالسلطة من خلال قوله (إن خليل تحدّث بنبرة متعالية، هي نفسها لهجة والده عند ذكره للمصريين، وغير مستبعد، أن يكون الولد أخذ تلك النعرة عن والده، وتكون السبب أو أحد الأسباب وراء الاعتداء الغاشم).
ثمة فارق أخير في المقارنة بين خطاب تاريخي متفق عليه، بل وعليه إجماع وانتشار وشيوع، وخطاب منزوٍ لا تتم الإشارة إليه كثيرا في كتب التاريخ، يتجلى ذلك في تصوير لحظة النهاية الخاصة باغتيال عباس حلمي، فالسبب الرئيسي الذي تذكره الكتب التاريخية يتمثل في سوء معاملته لبعض مماليكه، فاجتمعوا عليه في نوبة من نوبات حراسته وقتلوه. ولكن خطاب رواية أفندينا لا يكتفي بهذا السبب بمفرده، وإنما يضيف إليه سببا آخر عملت الرواية على التأكيد على مشروعية حدوثه من بداية السرد من خلال التوجيه السردي الخاص بخصومة عمته نازلي له ولأمه.
فقد أشارت الرواية إلى الخطاب المتفق عليه والمرتبط بضلوع مماليكه في قتله، لأنهم أكثروا الغمز واللمز لمن عينه رئيسا عليهم، وهو حسين باشا الصغير، وقد أمر عباس حلمي بجلدهم، وإرسالهم للإسطبل للعمل، وتشفع لهم رئيس خزانته، فعفا عنهم وقتلوه. وقد جعل الخطاب الروائي عملية الاغتيال مشدودة إلى الجانب السابق، وإلى جانب جديد، وهي رواية مدام أولمب التي أشارت إلى أنها سمعتها بمصر في أوائل عهد إسماعيل، ودونتها في كتابها(كشف الستار عن أسرار مصر)، وهي رواية تفيد ضلوع عمته نازلي في مقتله، وإرسالها شخصين من تركيا للمشاركة في قتله.

 الخبر الثقافي موقع يهتم بكافة النواحي الثقاقية بمختلف مجالاتها وتغطية الأخبار الفنية .
الخبر الثقافي موقع يهتم بكافة النواحي الثقاقية بمختلف مجالاتها وتغطية الأخبار الفنية .