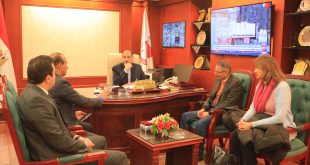إعادة بناء الوقائع في سيرة الذات الذاكرة
قراءة في سرديات رمضان : آيات ووجوه وأماكن لعيسى الشيخ حسن
د.خالد محمد عبدالغني
إن سيرة الكاتب والمؤلف والشاعر السوري عيسى الشيخ حسن، جاءت ضمن فعل التذكر الذي قامت به الذاكرة للراحلين وللأماكن، ولعلاقته مع شهر رمضان، ومعجزة الإسلام الخالدة “القرءان الكريم” وتتبع انعكاس العديد من الآيات القرآنية على نفسه ووجدانه وعقله.
.
إن الكتاب سياحة أدبية ومعرفية – سردية حكائية – دعاني الكتاب الحالي كما دعتني من قبل روايته خربة الشيخ أحمد للبحث عن جذور اللغة الشاوية، ولجذور أولئك القوم الذين سكنوا الشمال الغربي العراقي، والشمال الشرقي السوري، واعتمدوا في طعامهم وحياتهم على الشاة، في مرحلة مبكرة من تاريخ العرب، قبل انتقالهم لمرحلة الجمل والنخلة( ). ولعل هذا المخزون التراثي الشاوي العميق للمؤلف هو ما دفعه لأن يخرج لنا قصيدته الومضة “ثلاثة يعيشون في قطر . الجمل والنخلة وعيسى الشيخ حسن( )” التي كتبها قبل عام 2000.
.
لا خلاف على قيمة التذكر، ولا على أهميتها؛ فمن خلال فقداني للذاكرة لمدة خمس ساعات؛ أدركت بعدها أن الإنسان من دون ذاكرة ليس بإنسان، وليس بحيّ أيضًا؛ بل هو في عداد الموتى، أو لم يأت إلى الحياة الدنيا قطّ.
ونتيجة لإنشغالي بعلم النفس وما يتصل بالذاكرة في جزء منه، وتراث معرفي يؤكد أن الفارق بين الإنسان والحيوان ليس في اللغة؛ فلكلٍّ طريقته التعبيرية، فإذا كان لدى الإنسان الكلمات؛ فلدى الحيوان الأصوات، ولكن الفارق الوحيد هو الذاكرة، والقدرة على التذكر، وحكي الذكريات فليس بإمكان الحيوان أن يقص علينا ولو بالصياح ذكرى معينة لديه، ومن هنا يُعدّ المخ البشري كيانا مثيرًا للدهشة، فهو عالم خاص مليء بعدد غير محدود من القدرات الهائلة والأسرار الخفية، وهو دائمًا ما يتشكل، ويعيد تشكيل نفسه نتيجة للخبرات التي يمر بها، ويثار حول العقل البشري كثيرٌ من التساؤلات من مثل: كيف يتكون، وكيف يستطيع اكتساب الخبرات والتجارب المختلفة، وكيف يتوقف الزمان في داخله حتى نسترجع الماضي وتصور المستقبل من خلال الذاكرة؛ فالإنسان من دون ذاكرة لا شيء، ومن دون هوية أيضًا؛ فسلسلة الأحداث المترابطة وامتداد الماضي في الحاضر واستشراف المستقبل هو ما يشكّل إنسانية الإنسان، بل يمكن القول إن تحصين الإنسان ضد الموت والتلاشي رهين بما نحتفظ به في ذاكرتنا من مواقف عشناها، على الرغم من مُضِيّها، بحرارة الحاضر، ولعل فعل الكتابة نفسه إنما هو بغاية تفعيل الذاكرة، وترسيخها، ونقل تجاربها من الاجيال السابقة إلى الأجيال اللاحقة بغاية مراكمة التجربة الإنسانية، من حيث هي تاريخ يمتدّ بعيدًا ويترسّخ في الوجدان والتجربة الجماعية، ويمكن القول مع جون لوك بأن الهوية الشخصية الواسعة، تقوم على إدراك الإحساسات، والوعي بذلك الإدراك في كل زمان ومكان، الأمر الذي يجعل من الذاكرة مقوّمًا أساسيًا لقيام تلك الهوية، وهناك أهمية للذاكرة في بناء شعور الشخص بهويته لأنها تربط حاضرنا بماضينا، وتختزن كل التجارب التي نمر منها في حياتنا( ).
.
وتُعدّ الذاكرة الحسية الجزء الأول الذي يقوم على عملية استقبال المعلومات، والمدخلات الحسيّة من العالم الخارجيّ، والتي يتم من خلالها استقبال الكم الكبير من خصائص المثيرات الخارجية التي يتفاعل معها الإنسان من خلال الحواس الخمسة، حيث يختص كل مُستقبل حسيّ بحسب وظيفته بملاقاة المثيرات المختلفة، ويقوم باستقبال الخبرات الحسية بموجبها، فالمستقبل الحسي البصري يعمل على استقبال الخبرات البصرية على هيئة خيالات، والمستقبل الحسيّ السمعيّ يعمل على استقبال المثيرات السمعية على هيئة أصداء وهكذا. أمّا الدور الأساسي لهذه الذاكرة فهو نقل صورة العالم الخارجيّ بجميع مُدركاته، ومحتوياته بشكل دقيق، أي أنّها عملية تمثيل للواقع الخارجيّ بشكل متطابق وحقيقيّ، حيث إنَّ ما تختزنه هذه الذاكرة هو الانطباعات، أو الصور التي تعبّر عن مثير خارجيّ معين، وتتميز المستقبلات الحسيّة في الذاكرة الحسيّة بسرعتها الكبيرة في نقل الصور الخارجية للعالم الخارجيّ، والقدرة على تكوين الصورة النهائية لتصورات المثيرات المختلفة، وبالتالي؛ فإنّها تساعد في تحقيق السرعة في الاستجابات السلوكية التي تلائم هذه المثيرات.
أمّا في علم النفس فقد تم تعريف الذاكرة على أنّها الإمكانية التي يتم بموجبها تكييف السلوكيات بما يتناسب مع الخبرات التي يمر بها الإنسان، ومن الممكن تعريفها بشكل أوضح على أنّها عملية عقليّة معرفيّة تعمل على خزن وحفظ المعلومات، والخبرات والمواقف المختلفة التي يمر بها الإنسان ويتعلمها؛ وذلك بغرض استعادتها واسترجاعها عند الحاجة لها، ويقوم عمل الذاكرة على استعادة المعلومات المطلوبة بعد فترة من الزمن سواءً كانت طويلة أم قصيرة، ومن المهم ذكره أنّ مفهوم الذاكرة ذو معنى أشمل من مفهوم عملية التذكر، فعملية التذكر تشمل العمليات والنشاطات التي تقوم بها الذاكرة( ).
.
ومن ثم فالكتاب الحالي للكاتب والشاعر والاديب السوري عيسى الشيخ حسن إنما في حقيقته سيرة ذاتية لما احتوته الذاكرة بدقّة، ولما خانته فيه أيضا فهو بنفسه يقول: “وبعد غربة 23 عامًا، لم أعد أتذكّر بالضبط تاريخ وفاتيهما، ولكنّي أتذكّر بالطبع ابتسامة المحبّة التي ألمحها في محيّا الحجّ مضحي، وذكريات الحجّ حمزة مع أبي، وحرصه عليّ.
.
فما تذكره المؤلف جاء على ذكره وما لم يعد يتذكره أعمل فيه السرد والاستحضار، وربما قام بإعادة بناء الوقائع تلك الآلية الشائعة التي يعتمد عليها الإنسان حين تغيب الذكريات أو يصعب تذكرها. ولأنه يحكي لنا بصدق سنجد إعادة بناء الوقائع منذ بداية الذكريات فيقول لنا: “صيف 1975 (على ما أذكر)؛”. ولنلاحظ عبارة على ما أذكر، إننا هنا معه في حكايات سردية حتى وإن تلبست بثياب الذكريات المعاد ترتيبها وبنائها في آن.
.
ونكمل معه هذا الاستحضار لتلك الذكرى المهمة والتي تتقاطع مع جزء من ذكرياتي الذاتية أيضًا فالقارئ والناقد مع المؤلف يؤلّفون النصّ أحيانًا يقول عيسى الشيخ حسن: ” أوّل مصحفٍ ختمت به القرآن الكريم في رمضان كان “تفسير الجلالين”، بجلدٍ أحمر قاتمٍ سميك، وكان رمضان أيّامها يربط آخر الصيف بأوّل الخريف، وأذكر أنّي قرأت سورة البقرة كلّها في القراءة الأولى بعد السحور، وتباريت مع خالي عبد الكريم في القراءة، وكان عند بيت جدّي مصحف بورقٍ أصفر وخطّ كبير”. تقريبا في نفس المصحف ولكن بطبعة متوسطة الحجم 15 ×20 سم قرأت القرآن للمرة الأولى في عمر الثانية عشرة على ما أتذكر أنا أيضًا فكلّنا سيعيد بناء الوقائع – المؤلف والقارئ – وهالني أن حديث القرآن كان عن سيدنا موسى، وأنّ ذكر النبي محمد صلوات الله عليه كان قليلًا.
.
نتوقف عن التداعي لنعيش مع عيسى هذه التجربة المبكرة وهذا التذكر فيقول: “لم ينتبه ابن العاشرة كثيرًا للهامش الذي أوجز فيه الشيخان “جلال الدين المحلّي وجلال الدين السيوطي” رحمهما الله، شرح المفردات، بل راح يقرأ دون تدبّر ما أنجزه منذ ختمة القرآن في مدرسة العمّ الشيخ سليمان رحمه الله”.
ومثلما فعلت في كتابي عن رحلة الحج؛ حيث كان كتابًا جماعيًّا سمح لكل من له تجربة في الحجّ أن يكتب ذكرياته فيه، تصوّرت أنّ كتابًا آخر يمكن أن يكون حول رمضان؛ فكلّ مسلم له مع رمضان حال، وعلاقة خاصة؛ فقد شهد رمضان الأمة أحداثًا عظيمة وشهد رمضان الفرد إنجازات، ونجاحات عظيمة أيضًا، وفي هذا المعنى يشير المؤلف بقوله :” وفيهما – يقصد رمضانين متتاليين- عكفت على كتابة سرديّات تقارب رمضان، رمضان الذي كان، بطعامه وشرابه وأهله، ففي رمضان الأوّل ذهبت الذاكرة مذاهب شتّى، تستعيد طرائف رمضان التي تنقرض بهدوء، في بيوت الطين الحنون، وتتمثّل بعض الآيات التي تذكّرت من خلالها أهلي وأصدقائي وأساتذتي. وفي رمضان التالي، كنت قد عكفت على قراءة رمضان في السرد العربي، في تتبّع رمضان خلال كتابات الرحالة العرب، ولم أكمل العمل، فأهملته إلى حين.
وفي جزئه الثاني يأتي الكتاب على تذكر الراحلين الذين عرفت منهم اثنين المصري الشاعر محمود الأزهري ، والسوري الفنان والمخرج المسرحي أكرم اليوسف الذي أحب مصر واعتز بزيارته لها؛ فقد تابعت أخباره في الدوحة، من خلال علاقتي بالمسرح المدرسي، وفناني الديكور والصوت والإضاءة والاخراج المصريين آنذاك، ويقول لنا عيسى عن أولئك الغائبين: “ولكنّي في هذا العام، ذهبت في منحًى آخر، إذ تذكّرت من خلاله وجوه الغائبين الذين أثْرَوا حياتي، وأثَّرُوا فيها، ومنحوني من المحبّة الشيء الكثير، فتذكّرت طائفة منهم، ولو امتدّ بي رمضان لتذكّرت ضعفهم. وقد كانت نماذج تمثّلني في حياتي الممتدّة ستّة وخمسين عامًا، فتذكّرت العمّ والخال والمعلّم والجار، والمثقّف والأمّي، والمشهور والمغمور، ولكنّ الذي يجمعهم أنّي التقيتهم في محطات الحياة المختلفة، فمنحوني من المحبّة ما يفيض على طاقة العرفان، ومؤونة السرد.
وعن صديقي الشاعر المصري محمود الأزهري يقول “: التقيت ومحمود في مقرّ حزب التجمّع، للقاء الشاعر الراحل حلمي سالم الذي تعرّفت إليه في الدوحة، ثمّ في “مقهى البستان”، في المقهى قال لي: أمّي قالت لي: “رايح فين” فقلت لها، صديقي شاعر سوري جاي القاهرة، وانا رايح اشوفو؟ ع شان نروح الإسكندرية، نشوف الغروب اللي تكلّم عليه خليل مطران، قال ضاحكًا، أمّي ضربت يدًا على يد، وقالت “انتو مجانين”. نعم كان محمود مشرقًا بالظرف وخفّة الدم؛ ففي اليوم التالي وكنّا نمشي في القاهرة، وحانت صلاة الظهر، فقلت له: تعال نصلّي، فقال لي بصعيديّة جميلة: “إهيييه؟ احنا مش امبارح صلّينا؟”.
.
ويتذكر عيسى الشيخ حسن أيضًا المخرج أكرم اليوسف وكأني أحببت فيه حبه لمصر. هكذا أتصوّر الأمر حين أتعرّف إلى المبدعين سواء كانوا مصريين أو عربًا؛ فمهما كانت درجة إبداع أحدهم؛ فلا أحبهم إلّا لحبهم لمصر، ولهذا ربما لا أجد في نفسي ميلًا حتى لأولئك المبدعين المصريين المعارضين.
يشير المؤلف إلى ذكرياته مع أكرم اليوسف فيقول: ” كان أكرم سوريًّا دون تصنيف تالٍ، سوريّ وحسب، اقترب من جميع السوريين في الدوحة. شابّ في الأربعين، مقبل على الحياة، شغوف بالقراءة، ولا يكلّ ولا يملّ في العمل الإبداعي (صحافة- مسرح- نقد- …) واستطاع في بضع سنوات أن يكون من وجوه المدينة في الإعلام الثقافيّ، وحين انتقلت للكتابة في الشرق، كان أكرم قد جاء إليها أيضًا، محرّرًا، ومساعدًا لرئيس القسم، وطالما كان يتّصل بي مستعجلًا المادّة، أو طالبًا منّي تغطية حدث ما. وكان أكثر شغفه بالمسرح، فتراه أحد نجوم المهرجانات التي لا تكاد تغيب عن روزنامة الأحداث الثقافية “المسرح المدرسي- الشبابي- الخليجي- العربي..”، وفي سنوات تالية انتقل إلى “الجزيرة للأطفال” معدًّا للموقع “فيما أظنّ” وكانت القناة حديثة النشأة، وقد عملت فيها “مدقّقًا لغويًّا لفترة قصيرة” رفقة الكاتب التونسي حسن المرزوقي. وكان أكرم في الجريدة، وفي القناة، بمثابة أخي الأكبر، حريصًا على نجاحي حرصًا كبيرًا.
رحم الله كل الراحلين.
 الخبر الثقافي موقع يهتم بكافة النواحي الثقاقية بمختلف مجالاتها وتغطية الأخبار الفنية .
الخبر الثقافي موقع يهتم بكافة النواحي الثقاقية بمختلف مجالاتها وتغطية الأخبار الفنية .