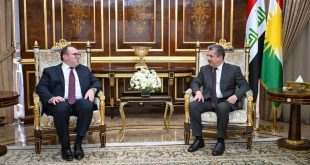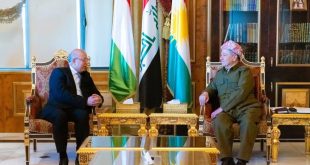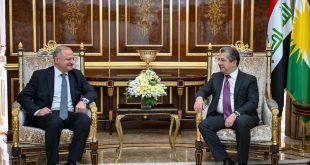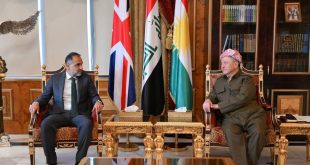بعد اعتداء حركة طالبان على الموسيقى ، وتحطيم الآلات الموسيقية في معهد الموسيقى في العاصمة الأفغانية كابول ، لنتأمل ما كتبت عن الموسيقى في الإسلام ( 1 ) :
هل قرأ السلفيون القرآن والسنَّة ؟
الذين يُجيزون الغِناء يفوقُون الحصر ، سواء كانوا في أيام الصَّحابة ، أو في أيام التابعين ، أو من جاء بعدهم ، إذ العارف بتاريخ الإسلام يدرك أنه كان هناك مُغنون ومُغنيات في عهد النبوَّة ، وزاد عددهم وعددهن في عهد الصحابة .
وعلينا أن نقول باطمئنانٍ إن الاستدلال بإجماع العُلماء في مسألة الغناء والموسيقى أمرٌ غير مُجدٍ لأنه مجافٍ للحقيقة ، وغير مقنع من الذين يُحرِّمون الغناء والموسيقى في أيامنا هذه ، أيًّا كان مذهبهم ، وهم عندي مُجرَّد مثيري فِتن لا أكثر ، لا يبتغون صلاحًا ولا إصلاحَا ، ويريدون دعايةً لا دعوةً ، لأنَّ أغلبهم – بالفعل – لا يرقى إلى مستوى العالِم العارف ، أو الفقيه الفاهم الدارس ، وليس من بينهم علَّامة ، يمكن للمرء أن يطمئن إلى اجتهاده ، ومن ثم يستطيع أن يجادله بالحُجَّة والدليل .
والقاعدة كما هو معروف ومستقر في الأذهان هو إباحة الغناء في كل العصور بدءا من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ، وحتى آخر شيخٍ مستنيرٍ قارىءٍ لتراثه ، عارفٍ بدينه ، لا يبتغي مطلبا ما من وراء فتواه . إذْ ماذا نقول – مثلا – في عبد الله بن الزبير (2 هـ – ٦٢٤ م- 73هـ – ٦٩٢ م ) وهو صحابيٌّ ، وابن صحابيٍّ هو الزبير بن العوام ، وأمه أسماء بنت أبي بكر الصديق ، الذي كان في بيته جوارٍ يعزفن على العُود ، فدخل عليه ابن عمر بن الخطاب ، ورأى بجواره عودًا ، فقال له : ” ماهذا يا صاحب رسول الله ؟ فناوله إياه ، فتأمَّله ابن عمر ، فقال : هذا ميزان شامي ؟ قال ابن الزبير : يُوزَنُ به العقول ” .
كما أن مذهب الإمام مالك بن أنس (93هـ – 715م – 179هـ -796م) يُبيح الغناء بالمعازف ، أي مصحُوبا بالآلات الموسيقية ، ولم يكن هناك خلافٌ بين أهل المدينة في مسألة إباحة العود أو عدم إجازته ، كما أن بعضًا من الشافعية ( نسبة إلى الإمام الشافعي 150 هجرية – 204 هـ / 767 ميلادية – 819 م” ) يُبيح العُود.
وهناك عدد كبير من العلماء والفقهاء والأئمة قد جزمُوا بالإباحة ، وحلَّلوا سماع الموسيقى ، وهذا يؤكد أن الدين الإسلامي دينُ يُسرٍ لا عُسرٍ ، ولكن يبدو أن الذين يفقهون القواعد الدنيا في الدين قد اختفوا ، أو وضَعُوا على قلوبهم أقفالا ، وصَمُّوا آذانهم ، وذهبوا نحو التشدُّد والتزمُّت والتنفير .
إن الموسيقى عندي معروفٌ ، ينبغي أن نأمر به ، لأنها تصفِّي وتنقِّي وتحمي ، وتثقِّف الرُّوح ، وتجلو النفس ، وتُرهِف الوجدان ، وتُذهِب الحُزن ، هي من الطيبات التي تحِلُّ لنا ، ولم تكن أبدًا من الخبائث المُحرَّمة ، أو مفسدة من المفاسد .
وأي تحريمٍ للموسيقى والغناء ، ليس من الشرع في شيءٍ ، إذْ فيها منافع وأدواء للقلب ، والنصوص التي تُجيزها صريحةً ، ولا تحتاج إلى تأويلٍ أو تفسيرٍ أو شرحٍ ، ولكنَّ المنوطَ بهم تعريف الناس بصحيح دينهم لا يعلمون ، أولا يعرفون إلا القشُور ، أو ينشرون مذهبًا ما ، عماده التحريم والتجريم والتكفير والتشدُّد ، لأنه من غير المعقول أن نترك رُخَصًا منحها الله ورسوله لنا ثم يأتي هؤلاء ؛ ليضيِّقُوا ما وسَّع الدين وأباحه .
والموسيقى – بشكلٍ عام – ليست أمرًا مُشتبهًا ؛ كيْ نتقيه ، والاشتباه ليس فريضةً ، وليس واجبًا دينيًّا ، كما أن المسلم ليس هشًّا في دينه ، كي تفتِنَه أغنيةٌ ما أو موسيقى ، والأصل في الأشياء الإباحة كما تقول القاعدة الفقهية ، وليس التحريم وعدم الإجازة ، وقد حلَّ الله لعباده الطيِّبات ، وخلق لهم ما في الأرض جميعًا ، ومن ثم لا يُمكن أن نُحرِّم أمرًا إلا إذا كان هناك نصٌّ واضح صريح مباشر من القرآن أوالسنَّة ، وما دام الله سبحانه وتعالى لم يذكر نصًّا في كتابه الحكيم – القرآن ، فلا يحرمن أحد الغناء والموسيقى ؛ لأن الله ( لم يكن لينسى شيئا ) ، ( وما كان ربك نسِيَّا ) سورة مريم 64 .
وتروي السيدة عائشة : ( كان في حجري جارية من الأنصار – وكانت قريبةً لها – فزوجتُها ، فدخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه يوم عرسها ، فلم يسمع غناء ولا لهوًا ، فقال : يا عائشة هل غنيتم عليها ، أو لا تغنون عليها ؟ ثم قال : إنَّ الأنصار قومٌ فيهم غزَلٌ ، ويحبون الغناء ، ويعجبهم اللهو ) .
والغناء – عمُومًا – ليس معصيةً بشهادةٍ من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولعلَّ الحديث الذي أورده ابن تيمية (661 – 728هـ ، 1263-1328م ) ، وهو المرجع الأول والأساسي للسلفيين وبعض أصحاب المذاهب المُتشددة ، والجماعات المُتزمتة خيرُ دليلٍ على إجازة الرسول للغناء ومعه الخلفاء الراشدون واحدا بعد الآخر في جلسةٍ واحدة ، حيث نقل ابن تيمية عن رواية الإمام أحمد بن حنبل (164 – 241هـ ، 780 – 855م) وتصحيح الترمذي (209 هـ – 279 هـ) = (824 م – 892م) ، وهو إسناده قوي : ( خرج رسول الله – صلى الله عليه وسلم – في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت : يا رسول الله إني كنت نذرتُ – إنْ ردَّكَ الله سالمًا – أن أضرب بين يديك بالدفِّ وأتغنَّى ، قال لها : ” إنْ كُنتِ نذرتِ فاضربي وإلا فلا ” وفي روايةٍ أخرى ” أوفِي بنذركِ ” ، فجعلت تضرب ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثم دخل عليٌّ وهي تضرب ، ثم دخل عثمان وهي تضرب ، ثم دخل عمر فألقت الدف تحت إسْتِهَا ثم قعدت عليه ، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : إنَّ الشيطان ليخاف منك يا عمر ، إني كنتُ جالسا وهي تضرب ، فدخل أبو بكر وهي تضرب ، ثم دخل عليٌّ وهي تضرب ، ثم دخل عثمان وهي تضرب ، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدفَّ } .
ومما يذكره الرواة عن الصحابة أنهم قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رخَّص للمسلمين اللهو عند العرس ، كما أنه أباح الغناء من قيْنةٍ ( جارية ) لزوجته عائشة ، وقد رواه النسائي (214 هـ – 303 هـ – 829م – 915م) ، ونص الحديث موجود في ” عِشرة النساء ” حديث 74 .
فهل بعد الرسول وأصحابه وتابعيه وزوجِهِ ، وقبلهم جميعًا القرآن ، دليلٌ على إباحة الموسيقى والغناء ؟
وهل سيكف المُحرِّمُون والمُكفِّرون من أهل السلف الذين يعيشون بيننا عن ترديدِ ما لا أساس له في القرآن والسنة ، ويتركون الناس ينظرون في دينهم الذي يُيسِّر ولا يعسِّر .
وأليس عند هؤلاء السلفيين مسائل أهم يتأملونها ، بدلا من بذر فتاوى التكفير في أرض من دخلها فهو آمن كما يقول الله عز وجل ( ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ آمِنِينَ ) ، ( ادخلُوا مصرَ إنْ شاء الله آمنين ) ،
( اهبطوا مصرَ فإنَّ لكم ما سألتم ) .
لا تأخذوا أمُور دينكم من سلفيٍّ
دعهم يا عُمر.
قالها رسول الله ، وهو ينهي عُمر بن الخطَّاب عن ضرب الأحباش ، الذين كانوا يرقصون بحرابهم ، ويغنون في ساحة المسجد النبوي ، وكان عُمر معرُوفًا بالشدَّة والصلابة ، ومع ذلك سنراه لاحقًا يغنِّي وحده ، ويسمح لمن معه من الأصحاب أن يُغنُّوا ، ولمَّا سئل عن غنائه قال : ” إنَّا إذا خلَونا قلنا ما يقول الناس في بيوتهم ” ، وكان يرى أنَّ الغناء يُقصرُ المسيرَ في الرحلة إلى الحَج ، ويجعل السفر سهلا هيِّنًا .
ولا أدري هل يعرف السلفيون الذين حَرَّمُوا الغِناء ، وكفَّرُوا أهل سماعه أنَّ الخليفة الثاني عُمر بن الخطاب هو من قال : ” إنَّ الغناء زادُ السفر ” ، كما أن الخليفة الثالث عثمان بن عفَّان قد سمح لجاريتيه أن يُغنيا ، وإذا ما حلَّ الظلام ، قال لهما : ” أمسِكا فإن هذا وقت الاستغفار .
هؤلاء الذين يُنصِّبُون من أنفسهم أئمةً وفقهاء ، وهم لم يُعلِّموا أنفسهم ، قبل أن يُعلِّموا غيرَهم من المسلمين ، وصدق الإمام علي بن أبي طالب في أمر هؤلاء ( … وليكن تأديبه بسيرته ..قبل تأديبه بلسانه ) .
وهذا السلفيُّ المصريُّ الذي يعيش بيننا ، أو أي سلفي آخر في مشارق الأرض ومغاربها ، ألم يسمع بقول عبد الرحمن بن عوف ((43 ق هـ / 581م – 33هـ/652م ، أحد العشرة المبشَّرين بالجنة ) :
غنِّنا يا أبا حسَّان ” يقصد شريكه في التجارة رباح بن المعترف ” ، ولمَّا مر عُمر بن الخطَّاب بهما ، سأل : ما هذا ؟ قال له ابن عوف : يقصِّر عنَّا السفر .
ولي أن أزيد أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب (ولد سنة 16 هـ ، و توفي 80 سنة هجرية ) في عهد الإمام علي بن أبي طالب كان يضع الألحان لجواريه ؛ كي يغنِّين ، ويسمعها منهن على أوتاره ، ولم ينهره أحدٌ ، أو يُكفِّر عليًّا .
ولم يكن عبد الله بن جعفر يرى في الغناء بأسًا ، وسماع الغناء عنه منشورٌ وذائعٌ ، وقد نقل عنه فقهاء كثيرون .
الإخوة من أهل السلف لم ينصتوا جيدًا إلى ” روِّحُوا القلوب ساعةً بعد ساعةٍ ؛ فإن القلب إذا أُكرِهَ عميَ ” ، ” ساعة وساعة ” ، أي ساعة لربك ، وأخرى لك .
ورغم أنني لم أعثر على حديثٍ نبويٍّ واحدٍ يذمُّ الغناء والسماع إليه ، ويحرِّمهما ، فإنني أجد أحدهم يكتبُ كتابًا عنوانه ” أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان ” ، أين هي – إذن – هذه الأحاديث ، حيث لا أحاديث تذمُّ ؟
وقد روى الزبير بن بكار بسنده : أن عبد الله بن جعفر راح إلى منزل جميلة – وهي إحدى المغنيات المعرُوفات في عهد الصحابة – يستمع منها ، لما حلفت أنها لن تغنِّي لأحدٍ إلا في بيتها ، وغنَّت له ، وأرادت أن تُكفِّر عن يمينها ، وتأتيه ليستمعه منها ، فمنعها ” .
وإذا كان عبد الله بين الزبير (2 هـ – 73هـ – 620 – 692 م ) ” يترنَّم بالغناء ” ، فمن أصدِّقُ ؟
هل أصدِّقُ فتوى السلفي الجاهل بشؤون دينه في تحريم الغناء وتكفير من يغنِّي ومن يسمع ، الباحث عن شأن الدنيا في تولِّي منصبٍ ، أو البحث عن سلطةٍ وسُلطانٍ لنفسه أولا ولجماعته بعد ذلك ، أم أصدق ابن أسماء بنت أبي بكر الصديق ، وكان له جوارٍ عوَّادات .
وفي كتابه ” الرخصة في السماع ” يذكر ابن قُتيبة الدينوري (213 هـ – 276 هـ / 828 م- 889 م) أنَّ الخليفة معاوية بن أبي سفيان ( وهو من أصحاب الرسول ، وأحد كُتَّاب الوحي ، وسادس الخُلفاء في الإسلام ، ومُؤسِّس الدول الأموية ، وأول خلفائها ) دخل على عبد الله بن جعفر يعُودهُ فوجد عنده جاريةً في حِجْرها عُودٌ فقال : ماهذا يا ابن جعفر ؟ فقال : هذه جارية أرويها رقيق الشِّعْر ، فتزيده حُسْنًا لحسنٍ تغنِّيها ، فقال : فلتقل ، فحرَّكت العُود ، فغنَّت:
أليس عندك شكرٌ للتي جعلت
ما ابيض من قادماتِ الرأسِ كالحممِ
وجددت منك ما قد كان أخلقه
طول الزمانِ وصرف الدهرِ والقدمِ .
قال : فحرَّك معاوية رِجلَه ، فقال له عبد الله بن جعفر : لِمَ حركتَ رِجلك ؟ ، قال : إنَّ الكريم طروبٌ .
وتذكر المصادر أن سعيد بن المسيب (637 – 715م / 14 هـ – 94 هـ – وهو سيد التابعين وأحد الفقهاء السبعة ) قد سمع الغناء واستلذَّ بسماعه .
ولقد مرَّ بي وأنا أقرأ في موضوع الغناء والسَّماع في الإسلام أن كثيرًّا من الفقهاء النسَّاك الزهاد المُتقشفين ، الراسخين في العبادة والورع والتقوى ، العارفين بالسُّنن والآثار ، العُلماء الحُفَّاظ ، كانوا يصوغُون الألحان ويسمعُونها من القيان ، ويُعلِّمون الجواري الغناء .
ويذكر ابن قُتيبة في كتابه ” الرخْصَة في السَّماع ” أن الخليفة عُمر بن عبد العزيز ( 61هـ \ 681م – 101 هـ \720م ) قبل أن يصير الخليفة الأموي الثامن ” كان يسمع من جواريه خصوصًا ، ولا يظهر منه إلا الجميل ، وكان ربما صفَّق بيديه ، وتمرَّغ على فراشه طربًا ، وضرب برجليه ” .
أما ابن جريج (80 هـ – 150 هـ – وهو من تابعي التابعين للرسول ) كلن من القلائل الذين يصوغون الألحان ، ويعرفون التمييز بين لحنٍ وآخر ، وكان يروح إلى الجمعة – كما يذكر ابن قُتيبة – فيمر على مُغنٍّ ، فيولج عليه الباب ، فيخرج فيجلس معه على الطريق ، ويقول له : غنِّ ، فيغنِّيه أصواتًا فتسيل دموعه على لحيته ، ثم يقول : إنَّ من الغناء ما يذكِّر الجنة ” .
وقد وصف ابن سيرين (33 هـ = 653م – 110 هـ = 728 م ) الدُّفَّ بأنه طعام النساء .
وعلى الرغم من أنني تربيتُ في بيتٍ أزهريٍّ ، لم أسمع فيه يومًا حتَّى عام 1975 ” أي سنة وفاة أبي عن تسعة وأربعين عاما ” ، أننا نتبع مذهبًا ما من المذاهب ، فقط أنا مسلمٌ وكفى ، وهذا ليس حالي وحدي ، ولكنه حال أغلب مسلمي مصر ، فإذا سألت أحدهم : أنت على أيِّ مذهبٍ ، ارتبك وتحير ، وسيجد مشقَّةً في الإجابة ؛ لأنه لا يعرف ، ولم يسأل نفسه يومًا سؤالا كهذا ، ولا سأله أحد من قبل ، على العكس في بلدانٍ عربية وإسلامية أخرى ، تعلي المذهب على الدين الذي تدين به ، بل ترفع المذهب على ما سواه ، وباستثناء الإخوان والسلفيين والجماعة الإسلامية بفروعها وبطونها واختلاف مسمياتها تضع الأمير أو المُرشد فوق رأس الدين ، ولذا تمنح نفسها كلَّ صباحٍ حق إصدار الفتاوى الجاهلة غير المستندة إلى صحيح الدين .
وإذا كان المصريون يتبعون مذهب الإمام الشافعي (150 هـ/766 م – 204 هـ/820 م) ، فهم يتزوجون على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان (80-150هـ / 699-767م) ، لأنه أيسر ، والمصريون يُفضِّلون اليسر لا العُسر في كل أمورهم دنيويةً كانت أو دينيةً ، كما رأوا منذ البدايات أن الاختلاف بين الأئمة رحمةً وليس إثمًا ، أو بابًا للنزاع ، إذْ هم أبناء الاختلاف لا الخلاف ، وهم غير معنيين بهذا المذهب أو ذاك حرفيًّا ، هم فقط معنيُون بالله ورسوله ، بالقرآن والُّسنَّة ، أما المذهبية فهي بعيدة عنهم .
وكان الرسول إذا خيِّر بين أمرين اختار أيسرهما ، وقد اختار – على سبيل المثال – أهل مصر المذهب الحنفي في الزواج ، لما فيه من حجج ترفع العنت والحرج .
ولعلَّ أشهر قول ردده المصريون هو ” زوَّجتك نفسي على كتاب الله وسنة رسوله وعلى الصداق المُسمَّى بيننا وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان ” .
وعندما سئل الإمام أبي حنيفة النعمان عن الغناء قال : ليس من الكبائر ، ولا من أسوأ الصغائر ، كما أنه هو الذي قال – أيضًا – : ” أما أنا فوددتُ أن لي غريما لازمني ، وحلف عليَّ فأدخلني إلى موضعٍ فيه سماعٍ فأسمعُ ” .
وألم يغن الإمام مالك بن أنس (93-179هـ / 711-795م) ومعه دفٌّ يضرب عليه :
سُليمى أزمعت بينا
وأين لقاؤها أينا ؟
ولم يعرف له نصٌّ في تحريم الغناء ، فيا أيها المصريون
لا تأخذوا أمور دينكم من سلفيٍّ ، يدَّعي العلم ، وهو ليس أهلا له .
 الخبر الثقافي موقع يهتم بكافة النواحي الثقاقية بمختلف مجالاتها وتغطية الأخبار الفنية .
الخبر الثقافي موقع يهتم بكافة النواحي الثقاقية بمختلف مجالاتها وتغطية الأخبار الفنية .