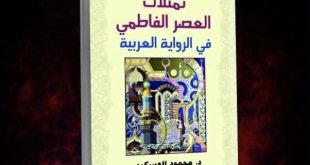“الأسطورةُ مؤولًا شِعرِيَّاً” قراءةٌ تأويليَّةٌ في نصِّ
” الكأس السادسة عشر: ابتهالات الخلاص” للشاعرة “ميلينا مطانيوس عيسى”
بقلم/ محمد عبدالله الخولي.
الأسطورة مكون ثقافي يستنزله المبدع في العمل الأدبي؛ ليكون شفرةً للمتلقي؛ من خلالها يستطيع أن يفك طلاسم النصِّ الإبداعيِّ، ويكتشف ماهيته عبر بنائه التمثيلي، وربما يكون استدعاء الأسطورة رمزا؛ يغرق النصَّ في متاهات الهرمنيوطيقا، فالأسطورة بناءٌ ثقافيٌّ تمتد جذورها وتنتمي إلى التاريخ، ولكنها -أعني الأسطورة- في حالة تشرذم دائم، وقلق دلالي لما تحتويه الأسطورة من إيحاءات ودلالات عميقة نظرا لتطورها وتغيرها عبر مسيرتها التاريخية، تلك المسيرة التي تخلق منها رمزا متوزعا ينطوي على مكنونات دلالية ربما تتباين حال تأويلها، ولعل ذلك يرجع إلى الغموض الذي يكتنف ماهية الأسطورة وتعريفها، كما تقول الدكتورة/ أمل مبروك: ” من الصعب إيجاد تفسير للأسطورة والإدلاء بتعريف شامل موجز لها، والخطأ هنا يكمن في السؤال نفسه؛ ذلك لأن الأسطورة كانت دائما موضع تحول دائم ومستمر، فهي كالكائن الحي تشمل ما في الحياة من تبدل وتغير وتطور وسيرورة. إنها بنية ثقافية من مجموع البنى المكونة لثقافات العالم عبر تطوره الحضاري، وعبر سيرورته التاريخية.” ومن وجهة نظرٍ خاصة، أعتبر الأسطورة مؤولا من مؤولات النص الإبداعي، وبوابة كبرى من خلالها يلج القارئ إلى العالم النصيِّ، قالنص بوصفه علامةً سيميائية بمفهوم ” تشارلز بيرس” (1839- 1914)، حيث قسَّم العلامة -وفق تقسيمه الثلاثي الشهير- إلى: [ممثل- مؤول-موضوع]- فمن خلال المؤولات النصية، والأيديولوجيات المرجعية والثقافية التي يشترك فيها كل من مبدع النص ومتلقيه- يستطيع المؤول/ الشارح الوصول إلى ماهيات النص الإبداعي، وأظن أن الأسطورة التي يستدعيها المبدع في عمله الأدبي مؤولا من المؤولات التي من خلالها نستبطن النص الأدبي؛ لاستظهار مقصديات الذات المنتجة للعمل الفني. وهذا ما نراه واضحاً جليَّاً في نص الشاعرة “ميلينا عيسى” والموسوم بـ “الكأس السادسة عشر: ابتهالات الخلاص” والتي ستفكك الأسطورة فيه شفرات النص الملغزة، ليطرح النص دلالاته ومعانيه التي يرمز إليها، فالنص مختزل مكثف لدرجة يصعب معها اللعب في تأويلات هذا النصِّ، ويجب أن يتوخَّى المؤول الشارح الحذر، وهو يتعامل مع مثل هذه النصوص، والتي تكون دائما على شفير بئر يوسفية عميقة، إن لم ينتبه القارئ وهو يفكك النص ويخطو خطواته التأويلية داخل دهاليز البنية العميقة، سيجد نفسه في هوة البئر السحيقة. فمن العنوان يبدأ المتلقي خطواته الأولى، ولكن العنوان صادم بمعنى الكلمة “الكأس السادسة عشر: ابتهالات الخلاص” تبتدر الشاعرة “ميلينا عيسى” العنوان بمفردة الكأس، وتختتم التركيب اللغوي للعنوان بمفردة الخلاص، وهاتان المفردتان تحلينا مباشرة إلى كأس “السيد المسيح” -عليه السلام- والذي تحول إلى أسطورة دينية نسجت حولها كثير من الأفكار والرؤى، كل يرتئيها وفق معتقده وطائفته التي ينتمي إليها- ونحن هنا لسنا بصدد هذا ولا يعنينا، فنحن نؤول عملا أدبيا، ونفتح بابه من خلال استخدامه رموزا تنتمي إلى الأسطورة- مع احترامي الكامل لكل المعتقدات الدينية السماوية- كي لا نفتح باب الجدال أمام سفسطة الجهال. ظلت كأس السيد المسيح رمزا دينيا أسطوريا، نسجت حوله كثير من التأويلات، حيث تباينت الرؤى واختلفت المرجعيات في فحوى القصة الشهيرة “العشاء الأخير للسيد المسيح”، فالكأس المقدسة “holy Grail” في الميثولوجيا المسيحية، كانت طبقا أو لوحا أو كوبا استخدمها السيد المسيح في العشاء الأخير، يقال أن الكأس ذات قدرة إعجازية، وقد حملها “يوسف الرامي” وانتقل بها إلى بريطانيا، وأسس سلالة من الحراس لحمايتها، وكان العثور على هذه الكأس هدف فرسان الدائرة المستديرة، التي كونها الملك “آرثر”. وفي فرنسا دُوِّنَتْ الأسطورة في شكل قصيدةٍ غير كاملةٍ، ودخلت الأدب الأوربيَ عن طريق الكاتب الفرنسي “كريتيان دي تروي” (1180-1219) وادعى أنه أخذها من كتاب حقيقي أعطاه إياه الكونت “Philip of Flanders”، وفي القرن التاسعِ عشر انتشرت هذه الأسطورة، بشكل كبير، وأصبحت أيقونة رمزية للأدب العالمي، فقد تناولها الشعراء والكتاب والروائيون في نصوصهم الإبداعية، كنوع من أنواع الإسقاطات الأسطورية الدينية.
وها هي ذي “ميلينا مطانيوس عيسى” تستهل نصها بعنوان يتصدره “الكأس المقدس” فالشاعرة تستدعي الكأس المقدس لأنها تنتوي “الخلاص” عبر صليب الكلمة المقدسة/ الشعر، ولكنها، قرنت الكأـس بعدد، أربَّك المؤول، فاستدخال العدد “السادسة عشر” يرتبط بتاريخ أو فترة عمرية معينة، أو رقم القصيدة في ديوان ما، أو دلالة عددية إشارية تظل مجهولة الهوية، ولكنها ذات علاقة وطيدة بــكأس ميلينا” الذي سيكون وسليتها الوحيدة “للخلاص”، هذا الخلاص يكون عبر ابتهالات أو طقوس معينة تخص “ميلينا” وحدها. فالذات المبدعة التي تنتوي الخلاص على صليب الابتهالات، والتي أظنها القصيدة/الشعر، فابتهالات “ميلينا” هي صليبها الذي ترتجيه، بعد أن تتناول نخب المحبة في “الكأس المقدس”. ولكن يظل العنوان غائما جدا، ولابد من النزول بحذر شديد إلى النص؛ لنستقرئَ العنوان من خلاله. تقول “ميلينا عيسى”
” الكأس السادسة عشر: ابتهالات الخلاص”
لا تَنْتَشِلُوا من عُيونِي ظَمَأَ الغيومِ
لرجلٍ يسيحُ كقطعَةِ شوكولا
تتشهَّاهاامرأةٌ
تمضغُ لبانَها في أرجوحةِ
الغدِ الجميلِ؛
لذا سأبدأُ
القراءة الأولى للمعزوفة النصية الأولى، تقذف لنا فكرة أخرى، تقترب كثيرا من أيقون “الخلاص” ولكنها تبتعد عن كون “ميلينا” هي التي تنتوي “الخلاص”، لأنها من خلال القراءة الأولى تنتظر “المخلص”. وبمفارقة عجيبة وصورة مدهشة فلسفية تقول “ميلينا” :”لا تنتشلوا من عيوني ظمأ الغمام” الماء ينتشل على وجه الحقيقة، ولكن عندما تكون “عيون الظمأ” هي الموصوفة بالفعل “لا تنتشلوا” فهذه مفارقة تصويرية عجيبة، إذ يتحول الظمأ إلى غمام ذي عيون، تتراءى للمتلقي، لتدخله إلى عيني “ميلينا” ليستقرئ هذا الظمأ الذي تشكل غيما وماءً، وكأن معجزة الكأس المقدس تتجلى هنا على نص “ميلينا” لتصنع تلك المفارقة التصويرية المدهشة، التي تدل على إبداع متفرد، وقلم يعرف مكامن سر الشعر، ويستنطقه عبر أدائية التمثيل النصي، نعم إنه قلم “ميلينا مطانيوس عيسى” الذي يصنع المفارقات ويرتقي باللغة إلى سمائها السابعة- “لا تنتشلوا” تلك الغيوم، لتظل تلك العيون في انتظار “رجل يسيح كقطعة شوكولا” هذا المخلص الذي تنتظره “ميلينا” “رجل يسيح” يتحول إلى ما تشتهيه “ميلينا” فمن جلال الصورة المدهشة الأولى، تنحدر بنا الشاعرة إلى بساطة أسلوبية، ربما تكون أكثر عمقا ومفارقة من الصورة التي ابتدرت بها النص، فالرجل/ المخلص هو القادر على الذوبان، قادر على أن يكون قطعة شوكولا حقيقية في فم”ميلينا”، وهي في انتظار مخلصها، وهي تمضغ لبانتها “في أرجوحة الغد الجميل” الفعل المضارع ” يمضغ” والذي يدل على الاستمرار المتصل بماضوية الأمل الذي يرجع تاريخه إلى “الكأس المقدس” والشاعرة وهي تنتظر مخلصها، تخلصت حقيقة من قيود الزمان والمكان وهربت من تلك الربقة إلى أرجوحة الانتظار، واستخدمت حرف الجر “في” والذي يفيد الظرفية والحلول، فالشاعرة المبدعة لم تقل “على أرجوحة الغد” ولكن قالت: “في أرجوحة الغد الجميل” دليل على تحقق الحدث، فهي بالفعل وفق تصورها تعتلي أرجوحتها في زمن مغاير ومكان مختلف بانتظار المخلص/ الرجل، وستظل هكذا في حالة انتظار دائم وهروب مستمر حتى يأتي “الرجل الذي يسيح كقطعة شوكولا”، وهذه الاستمرارية يدل عليها الفعل المضارع “تمضغ” ولكي تتمثل الصورة في ذهن المتلقي استخدمت الشاعرة مفردة “لبانتها” وإن كانت تلك الكلمة بسيطة في تركيبها، ولكنها معقدة جدا في تأويلها، فمن وراء تلك المفردة، تريد “ميلينا” أن تدخلك إلى عمق الصورة لتراها وهي تمضغ لبانتها في أرجوحة الغد الجميل في انتظار المخلص، ليس هذا وحسب ولكنها استدعت فعلا حركيا يضيف دينامية الحركة إلى المشهد فتقول “سأبدأ” لأنها وكما قلت متحققة من حدوث حقيقة الخلاص لها على يد رجلها المخلص، ولذا ستبدأ في عملية تغيير شاملة، لتؤهل العالم لهذا الرجل والذي تعتقد “ميلينا” فيه الخلاص من عذابات الظمأ الذي تفجر عيونا للشوق في عينيها، وشكل غيم الأمنيات. ولكن ما الذي ستبدأ به “ميلينا” وما التغيير الذي ستحدثه في العالم كي يكون مؤهلا لاستقبال المخلص. تقول “ميلينا”
“سأبدأ”
فقط لأغيِّرَ بعضَ شعائِرِ الأنبياءِ
التي لا تُشبِه كثيراً عُرْيَ آلهةِ الطِّينِ
أو حلوى الخطوم،
وكطائر الخزفِ القديمِ
من حيثُ لا ينتهي الحديثُ
عن الماء عن ظمأ الغيمِ”
قلت -آنفا- يجب التعامل بحذر شديد مع هذا النص، الذي يستخدم الأـسطورة، والمرجعيات الدينية بصورة ملغزة جدا، وملبسة لدرجة التعمية، التي ينغلق معها المعنى، وتكاد تنفلت من بين آيادينا رؤى التأويل؛ لذا يجب توخي الحذر، لنستبطن رؤية المبدعة “ميلينا” وكيف تعالج قضية “الخلاص” وفق منظورها الذاتوي.
توظف “ميلينا” أسطورة أخرى وهي “آلهة الطين” تلك الأسطورة التي تناولها التاريخ بصور متعددة، واختلافات تعود إلى طبيعة البلاد التي تؤول الأسطورة وفق منظورها، بآليات تتموسق مع المنطق الحضاري لهذه البلاد، فأسطورة “آلهة الطين” توزعت في القراءة والتأويل والمركزية الحكائية على كثيرٍ من الحضارات : “السومرية- اليونانية- البابلية- المصرية القديمة” تؤكد الكتب السماوية المقدسة على أن الإنسان خلق من طين، وأن اسم “آدم” عليه السلام- يعني”رجل الصلصال” أو “الترابي”، وأظن أن أهل الكتاب جميعا يعتقدون هذا الاعتقاد، ونحن به موقنون، وبالله العلي القدير مؤمنون، ولكننا نتعامل مع نص شديد الحساسية، يفرض علينا النظر إلى أسطورة “آلهة الطين” من منظورات أخرى، فلربما تنكشف أمامنا حقيقة النص ومقصدية المبدع، ونحن نستقرئ هذه الأسطورة، ولا سيميا أن عنوان الدراسة ” الأسطورة مؤولا شعريا.”
سنعرض هنا بعض وجهات النظر الحضارية في تأويل أسطورة “آلهة الطين” لأن كل الحضارات باختلاف أسسها ومرجعياتها، تتفق إجمالا على فكرة الخلق الطيني للإنسان، إذ الطين هو المادة الأولى التي تشكل منها البشر جميعا. فالحضارة السومرية تنص على أنه، بعد أن أخذ الكون شكله، واستقرت السماء في موضعها، وانتظمت دورة الليل والنهار، وأخرجت الأرض زرعها وتفجرت ينابيعها، تقول الأسطورة : “دعا الإله “أنكى” الصناع المهرة، وقال لأمه “نمو” أن الكائنات التي ارتأت خلقها، ستظهر للوجود، ولسوف نعلق عليها صورة الآلهة، امزجي حفنة طين، من فوق مياه الأعماق، وسيقوم الصناع المهرة بتكثييف الطين، ثم كوني أنت له أعضاءه، وستعمل معك “ننماخ” يدا بيد، وتقف إلى جانبك عند التكوين ربات الولادة، ولسوف تقدرين للمولود الجديد يا أماه مصيره، وتعلق عليه “ننماخ” صورة الآلهة، في هيئة الإنسان. يقول المفكر “فراس سواح” الأسطورة السومرية المتعلقة بخلق الإنسان، هي أول أسطورة خطتها يد الإنسان عن هذا الموضوع، وعلى منوالها جرت أساطير المنطقة، والمناطق المجاورة، التي استمدت منها عناصرها الأساسية، وخصوصا، فكرة التكوين الطيني للإنسان. أما حضارة اليونان، فقد ارتأت: “أن الآلهة أوحت إلى “برومثيوس” أن يخلق الإنسان، من تراب وماء، وعندما استوى الإنسان قائما، نفخت فيه الآلهة “أثينا” الروح، ثم راح “بروميثوس” يزود الإنسان بالوسائل التي تعينه على الحياة والبقاء. لن نعرض لوجهات النظر الأخرى لأن الفكرة المركزية واحدة، والذي استرعى اهتمامنا، لنعرض العرض السابق، هو استعمال الشاعرة “ميلينا عيسى” لمفردة الآلهة، والتي لا تنتمي إلى السياق السماوي، حيث هبطت الأديان السماوية المقدسة كلها، تنفي تعدد الآلهة، وتثبت العبودية كلها لله الواحد، كما تراه كل عقيدة وديانة من منظورها الخاص، والذي لا دخل لي به كناقد يناقش عملا أدبيا ونصا إبداعيا مفرط الحساسية.
فالشاعرة تريد أن تغير بعض شعائر الأنبياء، ولعل الأنبياء الذين تقصدهم “ميلينا” هم الادعياء وليس الأنبياء، فالأنبياء الرسل شعائرهم ثابتى مقدسة لا تقبل التغيير، ولكني أزعم معتقدا، أن “ميلينا” تقد ادعياء النبوة، الذين أدخلوا على الشعائر المقدسة ما ليس منها، تأويلات جديدة لا تنتمي إلى السماء، لأنها في أبسط صورها لا تلتقي حتى مع عري آلهة الطين، فكيف تلتقي وتتفق وتتسق مع فكرة الإنسان،الذي هو جوهر الرسالات السماوية المقدسة، تلك التأويلات والمدخولات الجديدة التي ينشرها ادعياء النبوة، في نفوس الناس، والتي تشبه “حلوى الخطوم” من حيث هشاشتها، وطعمها الذي لا يرتقي بالفعل إلى طعم الشوكولا، التي تنتمي إلى شجرة “البن” الإفريقية التي تنتمي إلى الأرض التي خلق منها الجسد البشري الراقي، فثمة مقارنة هنا بين ما هو اصطناعي وتمثله ” حلوى الخطوم” وبين ما هو طبيعي وهو “الشوكولا” حيث تشتهي ” ميلينا” طعم الشوكولا، الذي ينتمي إلى الأرض التي خلقنا منها، فثمة التقاء بين الفروع على أصل واحد. تستطرد “ملينا” في صياغة مقارنتها بين ما هو اصطناعي وما هو طبيعي ينتمي إلى الأصل الأول/ الأرض، فتستدعي “طائر الخزف” الصناعي الذي لا قيمة له ولا روح فيه، في مواجهة الحقيقة ومجابهة الطبيعي.
فــ “ميلينا” تبحث عن مخلصها الذي ينتمي إلى البدائية والفطرة النقية، ذلك الرجل الذي يسيح كقطعة شوكولا، في فم امرأة، سقطت سهوا في الموسيقى، فتقول:
أعني فقط
اقتلاعَ الشفاهِ
مِنْ أيقونةٍ ترتعِشُ على جسدِ امرأةٍ
تسقط سهوًا في الموسيقى، وفي غناءِ الرجلِ القديمِ؛
الرجلُ الذي لم يخطئْ فمُه قط في الحب والنشيدِ
ولا يموتُ عادةً في طريقِ عودتِه إلى الأرضِ
رجلٌ يعرِفُ ما لا يعرفه الربُّ
كقطعةِ شوكولا
تتشهَّاها امرأةٌ
تمضغُ لبانَها في أُرجوحةِ
الغدِ الجميلِ.”
تستهل “ميلينا” المقطع الأخير بـ “اقتلاع الشفاه” من قِبَلِ الرجل الأيقونة، الذي ينتفض على جسدها مرتعشا، ذلك المخلص/ الرجل البدائي ذو الفطرة النقية، والذي لم يتأثر بهذا الزمن وما به من تزييف وقلب للحقائق، فحواء الأولى تتجسد هنا في صورة ميلينا منتظرة آدمها الحقيقي” المعجون بنور السماء، حيث النفخة الأولى، فهو القادر على اقتلاع شفاه الألم، التي يستبدلها بالغناء الروحي والإنشاد المقدس، وستظل “ميلينا” في انتظار مخلصها، وهي تمضغ لبناتها في أرجوحة الغد الجميل.
كيف استطاعت المبدعة “ميلينا مطانيوس عيسى” الأبحار بنا عبر الأساطير والرموز الدينية والعقائدية، ومقارنتها بين ما هو اصطناعي وما هو طبيعي، أنزلتنا بحرفيتها في بحر متلاطم الأمواج، هائج لدرجة قصوى، كدنا أن نغرق فيه، لولا تعلقنا بتأويل شعري، ذي ألواح معرفية، ودسر ثقافية، جعلتنا بعد أن كدنا أن نسقط في هوة بئر التأويل، نمسك بأنامل الدهشة على شفير النجاة من هوة النص، الذي تشكل بناؤه على يد الشاعرة المبدعة “ميلينا عيسى” باحترافية المبدع الواعي، الذي يخلق من اللغة آفاقا جديدة بعد أن ينفخ روح تجربته في جوف الكلمات.
[النص]” الكأس السادسة عشر: ابتهالات الخلاص”
لا تَنْتَشِلُوا من عُيونِي ظَمَأَ الغيومِ
لرجلٍ يسيحُ كقطعَةِ شوكولا
تتشهَّاهاامرأةٌ
تمضغُ لبانَها في أرجوحةِ
الغدِ الجميلِ؛
لذا سأبدأُ
فقط لأغيِّرَ بعضَ شعائِرِ الأنبياءِ
التي لا تُشبِه كثيراً عُرْيَ آلهةِ الطِّينِ
أو حلوى الخطوم،
وكطائر الخزفِ القديمِ
من حيثُ لا ينتهي الحديثُ
عن الماء عن ظمأ الغيمِ”
أعني فقط
اقتلاعَ الشفاهِ
مِنْ أيقونةٍ ترتعِشُ على جسدِ امرأةٍ
تسقط سهوًا في الموسيقى، وفي غناءِ الرجلِ القديمِ؛
الرجلُ الذي لم يخطئْ فمُه قط في الحب والنشيدِ
ولا يموتُ عادةً في طريقِ عودتِه إلى الأرضِ
رجلٌ يعرِفُ ما لا يعرفه الربُّ
كقطعةِ شوكولا
تتشهَّاها امرأةٌ
تمضغُ لبانَها في أُرجوحةِ
الغدِ الجميلِ.”
 الخبر الثقافي موقع يهتم بكافة النواحي الثقاقية بمختلف مجالاتها وتغطية الأخبار الفنية .
الخبر الثقافي موقع يهتم بكافة النواحي الثقاقية بمختلف مجالاتها وتغطية الأخبار الفنية .