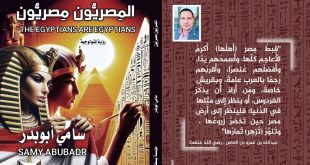“الفَضَاءُ المُتَخَيَّلُ وتَجَلِّيَّاتُ الهُويَّةِ في البناءِ السَّردِي”
قراءةٌ نقديةٌ في روايةِ “خَلِيَّةُ النَّحْلِ” للروائِي”أحمد البحيري”
الباحث والناقد/ محمد عبدالله الخولي.
إن الدراسات الأدبية والنقدية أهملت مكونًا هامًا من مكونات الخطاب الأدبي شعرًا كان أو سردًا، وربما لم تنفرد دراسة عربية نقدية تؤسس لهذا المكون، والذي أعني به ” الفضاء المرجعي” أو “مرجعية الفضاء”، وإن شئت فقل: “الفضاء المتخيل”، ولعل الكتاب الوحيد الذي تناول هذا الموضوع، وعالجه معالجة واعيةً، تحررت من قيود المكان، هو كتاب “شعرية الفضاء المتخيل والهوية في الرواية العربية” للناقد المغربي/ “حسن نجمي”، والذي لم يَدَّعِ في كتابه التنظير لهذا المكون، ولكنه اكتفى أن يحرر مصطلح “الفضاء” كمرجعية موضوعاتية للنص الأدبي، من براثن التعالقات المكانية المادية، فنرى “حسن نجمي” في مقدمة دراسته الواعية عن الفضاء المرجعي، ينوه على أن الفضاء يختلف اختلافا كبيرا عن المكان، ويرجع السبب في هذا الالتباس إلى الجناية القصوى التي قام بها الناقد “غالب هلسا” وهو يترجم كتاب “شعرية الفضاء” لــ” غاستون باشلار” المكتوب بالفرنسية عن الإنجليزية، وهو واقع تحت ضغط شغف غامض بأهمية المكان في الكتابة الأدبية، فقد ترجم الكتاب إلى عنوان “جماليات المكان” ويرى “نجمي” أن تلك الجناية التي ارتكبها “غالب هلسا” لم تتوقف حتى الآن، حيث ظل يختلط مفهوم الفضاء بمفهوم المكان مع اختلافهما، وهذا ما تطلب توضيحات متتالية من باحثين ونقاد ومبدعين مغاربة قاموا بإزالة هذا اللبس الواقع بين مفهومي [الفضاء- المكان] وعلى رأس هؤلاء النقاد ( محمد بنيس، حسن بحراوي، حميد لحميداني، محمد برادة)، فكأن تلك الجناية التي قام بها “غالب هلسا” كانت هي السبب الرئيس في تلك الإشكالية المصطلحية التي جعلت الفضاء مساوٍ للمكان، وهذا يرجع إلى أهمية الكتاب المترجم لـ “غاستون باشلار”، والذي جاءت ترجمته على يدِ “غالب هلسا” ترجمة تجانب الصواب، ولا تهتم بالمضامين والقصد الذاتي للمؤلف الأول، وقد اتهمت هذه الترجمة فيما بعد أنها ترجمة غير متأنية وليست بالرصينة، فقد اختلفت ترجمة “هلسا” عن مقصودية “غاستون باشلار” الذي كان يتحدث في كتابه الشهير عن شعرية الفضاء المتعالي برؤية الذات المبدعة، لا عن جماليات المكان كحيِّز مادي تتقولب فيه وبه الأحداث.

ولعل القارئ الحصيف لهذه الدراسة، يتساءل عن الفرق ما بين [الفضاء، المكان] قبل التوغل في متنها، إن اللغة التي ترتقي بآلية الإبداع إلى الأدبية، ينحرف فيها المبدع انحرافا من شأنه أن يوِّلد دلالات متعددة للنص الأدبي، وليس الهدف الذي يتغياه المبدع من هذا الانحراف هو جمالية النص وحسب، بل يقصد المبدع بهذا الانحراف المتمثل في اللغة غايات أخرى تتجلى في مغامرة القراءة التأويلية أو النقدية للنص الأدبي. وهذا الانحراف مبعثه الأول هو رؤية الذات المبدعة للعالم، عبر فضاءاتها المتعددة، فلكل ذات فضاؤها الذي يتشكل وفق استراتيجية فكرية معينة وأيديولوجية خاصة ومرجعيات عقائدية ينبني عليها هذا الفضاء، ومن ثم يكون هذا الفضاء المتخيل للذات المبدعة هو المرجع الحقيقي للعمل الأدبي، إذ تكون الرواية انعكاسا لهذا الفضاء المرجع، ولذا فإن استدعاء المكان بوصفه مسرحا للأحداث في العمل الروائي الجاد، ليس استدعاء للطابع الطوبوغرافي للمكان، وإنما باعتباره رمزا أو إيحاءً أو دلالة تخرج المكان من حيثيته المادية وطابعه الجغرافي، بعدما يتشبع المكان برؤية الذات المبدعة، ويصطبغ باستراتيجية نمطها التفكيري، فاستنزال المكان في النص المسردن لا يكون إلا بعد أن يتعالق أو يتعانق مع الفضاء الذاتي المتخيل، فالنص الأدبي لا ينقل الواقع بحرفيته، فالمبدع ليس ملزما بنقل الواقع بصورته الحقيقية في العمل الأدبي، إذ يتنافى هذا مع فكرة الإبداع وغاية الأدب، ولذا فالنظر إلى قضية بعينها في نص شعري أو سردي ما، يحتم علينا الرجوع إلى الفضاء المتخيل للذات المبدعة، وبهذا نستطيع أن نقول من خلال معالجة النصوص التي تتخذ من القضية الفلسطينية موضوعا لها، أن المرجعية فيها ليست للمكان وإنما للفضاء، فالذات التي تتخذ من هذه القضية موضوعا لها، لا تقف عند حدود المكان بطابعه الجغرافي، وإنما تتخطى ذلك إلى ما هو أبعد وأعمق من فكرة المكان نفسه، تتجاوز الذات المكان مع أهميته التي لا ننكرها، إلى أبعاد أخرى تصل إلى بؤرة التجربة الذاتية، فالدفاع عن القضية الفلسطينية له تداعيات أخرى دينية وعقائدية وأيديولوجية وعصبية منحت المكان قيمته الفعلية، فالمكان إذا تجرد عن هذا المنظور فقد قيمته الحقيقية وجوهره ومركزيته. ” فالمكان يمثل الإطار الذي يحوي العناصر السردية التي يشخصها الراوي لبناء عالمه الحكائي، فهو يحوي الشخصيات التي تتحرك خلاله، ويحوي الأحداث التي تنهض بها هذه الشخصيات، كما أنه لا ينفصل عن عنصر الزمان، فهما يتحركان داخل إطار روائي من الصعب فصل أحدهما عن الآخر إلا للضرورة القرائية، فالروائي الماهر هو الذي يوهم قارئه بمصداقية ما يرويه من خلال واقعية الأمكنة التي يسردنها داخل النص على الرغم من صفة التخييل التي تطغى على هذه العناصر، فأي نص أدبي -مهما كانت واقعيته- فهو نص متخيل ولا يمكن التسليم بأمر خارج هذا الحكم إلا إذا كان سيرة ذاتية مطابقة للواقع مطابقة حرفية وإن كان هذا الأمر هو الآخر فيه وجهة نظر، فالمكان الروائي من هذا المنظور يظل جزءًا من العالم المادي ولكنه محمل بدلالات رمزية” . فإذا كان المكان -بوصفه الأساس المركزي للمتن للحكائي- ينبني في الفضاء المرجعي ليتم شحنه بدلالات رمزية وإيحائية، فالشخصيات والزمان والصراع ليست ببعيدة عن ذلك فكلها مبنية في الأساس في أفق الفضاء المرجعي للذات المبدعة، باعتبار الرواية فنا أدبيا قائما على التخييل. وهذا لا يعني انفصال المكان عن الفضاء المرجعي للرواية، إذ المكان هو البؤرة الأولى التي انبثق عنها الفضاء وفقا لأبعاده الوطنية والقومية والدينية، فثمة تعالق ما بين الفضاء المرجعي المتخيل للذات وبين المكان كمرتكز محوري تدور فيه الأحداث، ومن ناحية أخرى فالمكان بمجرياته وتاريخه وأحداثه هو المشكل للذات وفضائها المتخيل، فلا نستطيع حال تأويل الرواية أن نتناسى المكان وفعاليته في البنائين “الحكائي والسردي” شريطة ألّا نتغافل عن الفضاء المتخيل الذي نعده مرجعا موضوعاتيا للرواية، فكثير من الدراسات التي لا حصر لها ولا عد تبلورت مضامينها حول المكان بطابعه المجرد المادي، ولم تلتفت من قريب أو بعيد إلى فضاء الذات التي شكلت الرواية بوعيها وتجربتها وأيديولوجيتها، وربما نجد بعض الدراسات تحمل المكان رموزا وإيحاءات دلالية، ولكن مع إغفالها الفضاء المتخيل للرواية الكامن في ذات المؤلف.
إذن، ومما لا شك فيه، بعد طرحنا السابق نستطيع القول: أن القراءات النقدية التي تتناول المكان في الرواية متعمقة فيه منشغلة بحيزه وحدوده، تفقد الذات المبدعة هويتها، التي لن يستظهرها الناقد إلا باستنطاق الفضاء المتخيل المرجعي لذات المؤلف، والذي على أساسه انبنت الرواية عبر مسارها السردي متنا وبناءً، خاصة بعد أن اتجهت الرواية العربية إلى دروب شتى متعددة في الطرح والبناء، وغاصت في الرمزية والتعقيد، نظرا لتطور الإنسان والكيفية التي يحيا بها، فلم تعد الرواية كسابق عهدها سطحية سهلة تسلم قيادها للقارئ بسهولة ويسر، بل أضحت الرواية ملغزة لتواكب النمط التعقيدي الذي أغرق الإنسان فيه طوعا وكراهية.
رواية “خلية النحل” للروائي “أحمد البحيري” من هذا النوع الملغز جدا، والذي عبر بنائه السردي استطاع أن يشيدَ صرحا، عاليا وقصرا مشيدا في حديقةٍ مسورة بطلاسم الرمز الشعري، الذي استطاع أن يقيم برزخا بين جوهر الرواية وسطحها اللغوي، فكان لزاما على القارئ أن يفكك هذه الطلاسم المربكة ليتخطى سور الحديقة ومن ثم يصل إلى مكامن الحقيقة في قصرها المشيد ليكشف عن خبايا ذات المؤلف السارد. فعبر الفضاء المتخيل والذي أعده مرجعا لهذه الرواية، تمكن “البحيري” من بناء روايته بناء متخيلًا غير منفصل عن الواقع المتجلي في المتن الحكائي للرواية من أماكن وشخوص وأحداث وزمن، ولم تكن الأماكن التي استدعاها “البحيري” بشخوصها وأحداثها غير رموز أغرقها المؤلف في متاهات التأويل، ضربا من التعقيد تعمده المؤلف في الرواية؛ لينقل لنا القلق الإنساني، والتشتت الذاتي للمؤلف وهو يبحث بل ويحارب من أجل هويته، والهوية هنا ليست هوية الذات الساردة، بل هوية الإنسان التي ضاعت مشتتة بين قبلية الأعراف والخروج عليها وبين المدينة التي ارتكزت على العلم والمعرفة بوصفهما لبنة الأساس الأولى التي ينبثق منها الكيان المدني، والذات التي تبحث عن حقيقتها ما بين تاريخها المتجذر في الصحراء والقبيلة وبين المدينة وما آلت إليه، وبين هذي وتلك نرى الإنسان مشتتا ضائعا فاقدا لهويته متوزعا بين الدروب محاولا العودة إلى سيرته الأولى وفطرته التي فطره الله عليها، ولكن الذات المؤلفة والتي تمثل الجنس البشري كله نائبة عنه في هذه الرواية ضلت طريقها وهي تبحث عن تلك الهوية، حتى فتحت أمامها طاقات النور، ومن ثم استطاعت تلك الذات أن تحدد طريقها، لتصل إلى ماهيتها عبر الحب الذي ننسى كل شيء إلا هو كما يقول “البحيري” في روايته على لسان الحارس “النسيان نعمة والحب هو ما يجب أن نقول فيه حتى نموت”، فالحب هو الذي يفرش لنا دروب الحياة مهادا، يجمع الإنسانية كلها متعالية على كل الموانع التي جعلت الإنسان يتأبى على العيش مع غيره، نظرا لاختلاف العقيدة أو المرجعية أو الثقافة، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه كيف يستطيع الإنسان أن يصل لهذه الدرجة العميقة من الحب ليتقبل الآخر مهما اختلفت الطبائع والعقائد؟ ولنترك الرواية عبر سرديتها الذاتية تجيب عن هذا السؤال.
بداية من العنوان “خلية النحل” يضع المؤلف القارئ في مأزق تأويلي لهذا العنوان، وعن طريق الإرجاع القرائي من المتن إلى العنوان استطعت أن أوجه هذا العنوان توجيهات متعددة كلها تنتمي إلى مقصودية السارد، فالعنوان مكون من مقطعين: [ خلية، النحل] فالخَلِيَّةُ كمفردة لغويةٍ تتنازعها معانٍ شتى ولكنها كلها تدور في فلك واحد، فالخلية بيت النحل، والخلية من الإبل التي خُلِّيَتْ للحلب، والخليَّةُ المطلقة من عقالها لترعى حيث شاءت، وهي السفينة التي يتبعها زورق صغير، وتعرف الخلية عادة بأنها أصغر وحدة حية، وأنها الوحدة البنيوية والوظيفية لجميع الكائنات الحية، ومعنى كونها وحدة بنيوية هو أن بناء كل كائن حي بأنسجته وأعضائه ناتج عن تآلف عدد كبير من الخلايا، وبهذا المعنى تعرف الخلية بأنها لبنات الحياة. أما كونها وظيفية فمعناه أن جميع وظائف الجسم الكبرى ناجمة عن مجموع الوظائف التي تؤديها كل خلية على حدة. وقد أطلق عليها العالم الإنجليزي “روبرت هوك” [cells] والتي تعني: غُرف الصوامع أو الأديرة التي يتعبد فيها رهبان النصارى وذلك لما بينهما من شبه من حيث الشكل، فعندما وضع “روبرت هوك” الخلية تحت المجهر وجدها تشبه الصوامع أو الأديرة التي يتعبد فيها. ومن خلال ما سبق يتبين لنا أن معنى الخلية يدور حول البناء فهي أساس الحياة لكل الكائنات الحية، وهي الإنتاج الناتج عن عمل دؤوب كخلية النحل، ولها وجه آخر وهو النفع والخير فهي الناقة التي خليت للحلب، وهي الأساس البنيوي الذي قامت عليه الحياة، ومن حيث الشكل فهي تشبه الغرف التي أعدت للعبادة، وهي الناقة التي خليت وانتزع عنها عقالها لترعى حيث شاءت، وهذا يضيف لنا معنى جديدا ذا علاقة وطيدة بمقصد السارد وهو الحرية المطلقة، وهذا ما نلمحه في قول “البحيري” على لسان أحد الشخصيات في المختبر وهو يدعو ويقول : اللهم أنقذ مطلقك الكامن في الإنسان”
أما بالنسبة للمكون الثاني للعنوان وهو “النحل” فهي حشرة تنتمي لرتبة غشائيات الأجنحة، ووظيفتها إنتاج العسل وشمع النحل والتلقيح، يعرف منها ما يقارب من 20000 ألف نوع، وتنتشر في جميع قارات العالم عدا القطب الجنوبي. وبالرغم من أن أكثر الأنواع المعروفة من النحل تعيش في مجتمعات تعاونية ضخمة، إلا أن النسبة الكبرى منها انعزالية وذات سلوكيات مختلفة، ويعد النحل من أكثر الحشرات نفعا للإنسان، نظرا لمساهمتها في تلقيح الأزهار. وقد ورد ذكر النحل في الكتب السماوية قاطبة، ففي القرآن يقول الله تعالى في سورة النحل [وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ]. أما في الكتاب المقدس فقد ورد ذكر النحل بنوعيه : [البري- الداجن]، وأن “البريَّ” منه مآواه الصخور وعيشه على الجبال والأشجار[مزمور 81 عدد 16] وأما “الداجن” ورد ذكره في [سفر الخروج، إصحاح 3، عدد 8،17] في سياق الحديث عن أرض الميعاد ووصفها بأنها البلد التي تفيض لبنا وعسلا، كما ذكر الكتاب المقدس خصيصة ينماز بها النحل عن سائر الكائنات، وهي أن النحل لا يهاجم إلا في حالة الاعتداء عليه [مزمور 118 عدد12] وكذلك في سفر التثنية [إصحاح 1عدد 44]، أما في التقاليد اليهودية، فيعتبر العسل رمزا للعام الجديد، وفي العهد الجديد المسيحي، يقال: أنه في عهد يوحنا المعمدان عاشت الناس فترة طويلة في البرية على نظام غذائي واحد يتكون من الجراد والعسل البري. وبمراجعة ما سبق تتجلى لنا دلالات تفيض بالمعاني والرموز، وأعتقد أن الروائي “أحمد البحيري” بعمقه المعرفي والثقافي الذي يتفجر ينابيعا في الرواية يقصد كل هذه المعاني، فالجماعة التي سمت نفسها بعد موسم الحج الأصغر بوادي “عيذاب” حيث يقطن سيدي الولي العارف بالله “أبي الحسن الشاذلي”- بجماعة “خلية النحل” التي أفرزت بعد تلك الزيارة سبعة آلاف شخص من أصل ستة وعشرين فردا، “كانوا يجوزون على درب الحكمة في ترتيب المخلوقات في الملأ الأعلى وعلى الأرض وفي أعمار الكائنات، كانوا يمدون الطوق إلى الداخل مثل شعاع الشمس النائم في جوف الإنسان، وكانوا يمدون ملايين الأيدي للبؤساء المحرومين. يروون حكايات العشاق مع المطلق، ويصدون الناس عن الأصنام، ويزيحون الوهم عن الأبصار. ويُقصون الخسران المتراكم في جوف الإنسان، كيما يستشعر آثار المطلق.” هكذا وصف “البحيري” جماعة خلية النحل. وباستقراء العنوان من خلال المتن الروائي، والنظر إلى مكونيه اللغويين تتجلى أمامنا عدة حقائق ودلالات، فالعنوان استعاري من تلك العنوانات التي أطلق عليها “فانسون جوف” في كتابه” شعرية الرواية” “العناوين الاستعارية” والتي يكون العنوان فيها واصفا لمحتوى النص عبر آلية الترميز وتقنية الاستعارة، والموقع الطوبوغرافي للعنوان وتصدره صفحة الغلاف وانفصاله عن المتن الروائي، يدل دلالة قاطعة على تصريحية الاستعارة، لحضور المشبه به كلية وغياب المشبه بالكلية في المتن السردي، والذي لا يتبين إلا بالتأويل والقراءة.
فخلية النحل المستعارة لجماعة “العابرين” أو “المسافرين أبدا” تحمل في طياتها مرتكزات هذه الجماعة وأسسها التي انبت عليها، فمفردة الخلية باعتبارها اللبنة الأولى للحياة وللكائنات الحية، تحمل إشارة العودة إلى الإنسان الأول، الذي لم تعكره الحياة بما آلت إليه الآن، وكأن الحياة أغرقت الإنسان في جب غيها غدرا، وهو يحاول الخلاص، ولن يقدر إلا بعودته إلى فطرته الأولى، لتتحقق هويته الإنسانية، التي خلقه الله من أجلها ليكون خليفته -سبحانه- في أرضه، ولذا وجب عليه التخلي عن طينية الجسد، والارتقاء على مدارج الروح، متساميا على دائرة انغلاق العقل المادي؛ كيما يصل إلى جوهره الحقيقي، “يا آخر الصابرين يا ابن المجد أنت فتانا، ومرتجى الأحلام في كل القبيلة. يا من على الأخطار كبر سنامه، وغدا أديم الأرض يعرف خطوه، ولسان حال الصمت فيه صار إلى المؤبد. ها قد أتتك الريح تركب متنها، ومسارب الأنهار صبت ماءها في البحر واشتاقت لطلعتك العيون. يا آخر الصابرين..” فالعودة إلى الإنسان الأول الذي لم تعكره الحياة خارجا عن دائرة انغلاق الجسد، وناموس العقل البشري، مطلقا سره وروحه في الملكوت الأعلى ليستنبط معنى الحياة الأسمى من ملكوتات الوصال، والتي لا يستطيع الإنسان الوصول إليها إلا بالصمت، فمن يحسن الصمت لزمته ملكة الفهم عن طريق الإصغاء لعالم السماء، وقد أشار سيدي محيي الدين بن عربي إلى هذا المعنى حيث قال: أن الإنسان يصغي إلى عوالم السماء، فيملى عليه، ثم يقول” وبالطبع ليست كل القلوب مهيأة لسماع السماء حتى وإن صمتت، ولعل هذا ما كان يقصده “البحيري” من الحوار الذي دار بين جماعة “خلية النحل” في بيت الحارس “قالت مريم: نعم إن العبقري يبدو كالفوضوي في عيون الآخرين: مثل الهر الذي يبقى متحفزا في انتظار الفريسة، كما هو الحال عند بعض العلماء والأدباء والشعراء والموسيقيين. كان لامارتين يقول: لست أنا الذي يفكر، ولكن هي أفكاري التي تفكر لي. وكان موسيه يقول: أنا لا أعمل شيئا، ولكني أسمع ما يلقى إليَّ فأنقله، فكأن إنسانا يناجيني.” وهذا الحوار يرجعنا مرة أخرى إلى العنوان رجوعا إجباريا، ونحن نستحضر قول الله -تعالى- [وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ]. ومحاولة الربط بين العنوان والآية الكريمة التي لم أذكرها عبثا في معرض الحديث، لأن الاستشهاد بهذه الآية -تحديدا- يفتح لنا أفقا تعريفيا عن معنى الإلهام السماوي والعلوم الربانية التي تسمو بقداستها عن الإدراكيات العقلية البشرية، فتلك الجماعة التي اعتاد أصفياؤها كــ “الحارس وعبدالله وغيرهم” الصمتَ وهم ينتظرون طائر الإلهام الذي يوحي إليهم باعتبار الوحي -لمن سلك طريق الخلاص الروحي- إلهاما وقذفا روحيا تنجذب له وبه القلوب الواعية العارفة، وكأن الأستاذ “البحيري” يشير لنا عبر سرديته الروائية إلى أسمى أنواع المعارف، وهو العرفان الروحي الذي يخترق فضاء الذات البشرية ويشحنها بطاقات العرفان السماوي، ولعل هذه الركيزة من أهم الركائز التي انبت عليها جماعة “خلية النحل”، “قال عمار: معنى ذلك أن العقل الباطن في الإنسان له اتصال بعالم غير هذا العالم ولكن يشعر به من لديه الاستعداد لذلك، فكل فكرة في هذا الوجود مهما كانت صعوبتها لابد أن تجد من يفهمها. قال جورج: ومعناه أيضا وقوع الإدراك بدون وساطة العقل العادي والحواس…، قالت رندا: ومعناه أيضا وجود اتصال روحاني باطني يمد الإنسان بعلوم ومعارف لا من طريق العقل ولا من منافذ الحواس، إن هذا الاتصال يؤكد وجود أطوار فوق طور العقل ويفتح الباب واسعا لحقيقة الوحي ونزول الرسالات.” ومن هنا نتبين أن الروائي طرح العنوان على صفحة الغلاف عالما بماهيته، فالنحل باعتباره رمزا استعاريًا يحمل دلالات متعددة أظنها مقصودة لتتموسق مع غايات الذات الساردة.
إن رواية “خلية النحل” تتعالى على الأيديولوجيات والمرجعيات الثقافية والفكرية، تنسلخ من المجتمع متجهة نحو الذات. فالرواية العربية الحديثة دخلت في مرحلة تجربية جديدة “منذ السبعينيات وخصوصا بعد هزيمة 67 وما ترتب عنها من صدمة مروعة للوعي العربي، خطت من خلاله الرواية العربية مسارا مختلفا للواقعية سمته التجريب، حيث اتجه الروائيون إلى التخلص من الشكل الواقعي السطحي بتجريب أشكال روائية جديدة. بحيث تحولت بوصلة الرواية من المجتمع نحو الذات وتراجع صوت الأيديولوجيا والتاريخ والجماعة في النص الروائي ليعلو صوت الذات ووعيها الفرداني[…] عرفت هذه المرحلة أسماء كثيرة يصعب حصرها نذكر منها على سبيل المثال: جبرا إبراهيم جبرا، إدوار الخراط، الطيب صالح، صنع الله إبراهيم، حيدر حيدر، جمال الغيطاني، سليم بركات…” ومن وجهة نظر خاصة أرى أن الروائي “أحمد البحيري” امتداد لهذه الأسماء التي دخلت مرحلة النمذجة والتجريب متعالية برؤيتها الذاتية عن الواقع، فالذات السادرة في رواية “خلية النحل” تخط لنفسها مسارا سرديا مختلفا، تتجلى فيه حقيقة الذات متسامية عن واقعها، وهذا ما جعل “البحيري” يستحضر المكان برمزية مفرطة تنتمي إلى الواقع عن طريق فك شفرتها، وعندما تلتبس بالواقع بعد فك إلغازها، تفر منه لتسكن في فضاء العالم المتخيل في ذهن المؤلف، وكأن المكان برمزيته التي تعمدها “البحيري” ينتمي إلى الواقع، ولا ينتمي في آن، لأن ولاء المكان يؤول في النهاية للفضاء المتخيل للذات الرائية. وهذا ما يجعلنا نطرح عنوانا فرعيا متنه : الأيقون المكاني في البناء السردي.
– الأيقون المكاني في البناء السردي:
التقسيم الثلاثي لعلامة بيرس السيميائية، وخاصة ثلاثية العلاقات التي تربط الممثل بموضوعه، والتي تتوزع إلى [ إشارية- رمزية- أيقونية] وباعتبار الأماكن التي ذكرها السارد في روايته، لا ينظر إليها نظرا مجردا، وإنما بوصفها ممثلا لغويا عبر مؤوله ينتمي لموضوع عبر علاقة من هذه العلاقات الثلاث السابقة، وجدنا أن العلاقة التي تربط بين المكان والفضاء المتخيل باعتباره موضوعا لهذه الرواية هي “الأيقون” نظرا لتشابهها في بنائها السردي مع رؤية السارد، وانصباغها بسيكولوجية نفسية تخص الذات المبدعة، فالأماكن التي طرحها “البحيري” في روايته “خلية النحل” تتواءم مع الرؤية الكلية له، متناغمة مع مرجعيته الفكرية الصوفية، والتي تسعى إلى الخلاص الروحي، وخروج المطلق الكامن في الإنسان إلى معاريج الكمال.
إذن فالعلاقات المكانية “لا تعتبر مجرد إحداثيات مكانية هندسية مجردة لا علاقة لها بواقع الإنسان ومحيطه الاجتماعي والأخلاقي، بل تمثل مفاهيم تصورية أساسية في وصف الواقع الاجتماعي، وفي الأحكام الثقافية والأخلاقية وفي التصنيفات الأيديولوجية. فالاستعارات المكانية حاضرة بتقاطباتها في مختلف الأنساق. في المجال السياسي نجد التقاطب بين اليمين واليسار، وفي المجال الاجتماعي نجد التقاطب بين الرفيع والوضيع، بين أعلى الهرم الاجتماعي وأسفله، وفي الدين نجد التقاطب بين السماء والأرض، بين أهل اليمين وأهل الشمال، وفي المجال الأخلاقي نجد التقاطب بين السمو والتدني.” ويقترح الفيلسوف [غاستون باشلار] منظورا مغايرا للمكان يتجاوز الأبعاد الهندسية للمكان وعلاماته الجغرافية، للبحث عن قيمه الأنطولوجية اعتمادا على فاعلية الخيال[…] ولذا يجب ألا نعتبر المكان مفصولا عن تجربة الإنسان في الوجود، فالمكان هو فضاء يعيش فيه الإنسان ليس بشكل موضوعي فقط، ولكن بشكل رمزي، من خلال ما يحلم به الإنسان أو يتذكره، أي من خلال ما ينسجه الإنسان من علاقات بالمكان سواء كانت علاقات ألفه وحنين وانجذاب وتذكر، أو علاقات عداء ونفور وابتعاد ونسيان.” ، ووفق هذا المنظور نجد أن الأماكن التي اكتست بسيكولوجية الذات، انقسمت إلى قسمين: [ أماكن تألفها الذات- أماكن تنفر منها]، فالبنسبة للأماكن التي تألفها ذات السارد تمثلها ثلاث أيقونات مكانية وهي:
1- “دار الحارس” كلمة دار في إطلاقها توحي بالألفة بين المكان والمكين، ولذا اختار السارد مفردة “الدار” لتحمل في طياتها إيحاءً بالراحة والألفة والسكون. هذه الدار التي يجتمع فيها العابرون أو المسافرون أبدا، هذا المكان الذي يسع كل وجهات النظر وكل المعتقدات الدينية والفكرية، وباستحضار الشخصيات التي تلتئم في هذا المكان مكونة وحدة إنسانية ذات نسيج واحد، وكأنها انتظمت في عقد الوجود متوحدة بخيط المحبة؛ يتبين لنا مدى الارتياح النفسي الذي يستشعره “العابرون” وقت مكوثهم في دار الحارس “كان للحارس صالة كبيرة ملحقة ببيته يلتقي فيها عشاقه ومريدوه. وكان لها بابان؛ أحدهما واسع يأتي بعد بضع عتبات من مدخل الدار، والآخر ضيق ومستحدث في شرفة ترتفع عن سطح الأرض قرابة مترين. توجد شجرة كثيفة الأفرع أمام هذا المدخل الضيق، تنفذ أشعة الشمس من بينها بصعوبة.” أما بالنسبة لموقع الدار، فهي قابعة في قبيلة “الجرح” والتي ينتمي إليها الحارس. ولقبيلتي “الجرح والنزيف” موقعا مركزيا في الرواية؛ فكلتاها واقعة تحت وطأة الاستعمار والذي تمثله “قرية السراب” أحد أذرع “الصهيوماسونية” في منطقة القبائل، ولمركزية مفردة القبيلة في النص الروائي، وجب التنويه على رمزيتها وتوزعها بين أنحاء العالم، فالقبيلة أو مجموعة القبائل التي وردت في هذا النص الروائي هي [أم السمار- الجرح- النزيف- الصنوبر- الفيحاء- التاج- الأشجان- الأوراس]، بعد مطالعة الرواية وجدت أن هذه القبائل لا مركزية لها من حيث المكان، فهي مشتتة بين قارات العالم القديم، فـ قبيلة “التاج” تنتمي إلى قارة آسيا، وقبيلة “الصنوبر” والتي أولتها مستضيئًا بالمفردة اللغوية الصنوبر بـ “غزة” فهي القبيلة الوحيدة التي استعصت على الاستسلام لقرية “السراب” بضراوة المقاومة، وهذا التأويل ناتج عن البحث عن الأماكن التي تنتشر فيها شجرة “الصنوبر”، وقد وجدتها منتشرةً في “لبنان، وسوريا، فلسطين، الأردن”، ولكن مفردة “المقاومة” التي انسربت في النص الروائي، جعلتني أـختار فلسطين وخصوصا “غزة” وربما تتسق وتؤول قبيلة “الصنوبر” قراءة أخرى مغايرة، وتنسب إلى “لبنان أو سوريا” وفق قراءة المؤول الناقد، ولكني اخترت ما اخترت بعد ذكر “أرض السلام” أكثر من مرة في طيات الرواية. وقبيلة “أم السمار” والتي ينتمي إليها “عبدالله” أظنها مصر، نظرا لذكر الموقع الجغرافي للقبيلة في معرض الحديث عنها يقول “البحيري” : “لقبيلة أم السمار طبيعتها الفاتنة، يحدها من الشرق والشمال بحران عظيمان، ويشقها أطول أنهار العالم، وتحوي في تراثها أكثر من ثلثي المعمورة.” وربما يستطيع القارئ أن يحيل كل قبيلة من القبائل إلى مركزيتها المكانية وقارتها التي تنتمي إليها. فـ “البحيري” بين الفينة والأخرى يفك شفرة قبيلة ما، فقد اكتشفت أن “قبيلة التاج” تنتمي لقارة آسيا عند موت “الجهم”، وملمح آخر يتبدى في اللقاء الأخر من حيث زمن الرواية- هذا اللقاء الذي تلتقي فيه جماعة “خلية النحل” بــ “جماعة الخفاء” في مبنى ما يضم ثلاثة أبنية مستطيلة الشكل، كل بناء تتقدمه فتاتان، توزعت جنسياتهم بين “إفريقيا- آسيا- أوربا” من خلال ملامحهن التي أشار إليها الروائي، وهذا ما دفعني إلى القول: أن القبائل المذكورة في النص متوزعة على قارات العالم القديم، وإن كان ثمة تقارب ملحوظ بين قبائل “الجرح- النزيف- أم السمار- الصنوبر”، ولكن البعد المكاني بين هذه القبائل وتوزعها على مناطق شتى لم يمنع الشخصيات المنتمية لهذه القبائل من الانصهار في بوتقة المحبة والبحث الدائم عن الإنسان الحق المنشود في هذه الرواية، وهذا التمازج بين القبائل واستنزالها عن طريق البناء السردي المتعالي على قيود الزمان والمكان في “دار الحارس” حيث تلتقي هذه القلوب على اختلاف دياناتها ومعتقداتها- ينم عن عبقرية الروائي “أحمد البحيري”، والذي اسطاع أن يجمع الشتات، ويطوي المسافات، ويسخر الزمن السردي، ليخدم فكرة الرواية التي تنادي أنسانها الأوحد المنشود.
2- المختبر:
مكان لا مركزية له، فليس واقعا في حيز جغرافي محدد، ولا بقعة مميزة تدل عليه، حتى وإن حاول “البحيري” إيهامنا بغير ذلك، وربما يكون “المختبر” أحد دور العبادة المقدسة المتواجدة على أرض مدينة النور “باريس” وربما يكون مكانا ذا عبق تاريخي يحوي تراث العالم وامتداده الحضاري، ولكني بعد وصف “المختبر” من الداخل أكاد أجزم بعدم مركزية هذا المكان، فمن الممكن أن يكون دخول المختبر عبر تأملية الذات، حالة من الهروب أو السفر الدائم الذي انمازت به جماعة “المسافرون أبدا” أو “خلية النحل”، خلوة داخلية ذاتية لها حيز في الفضاء المتخيل للذات المبدعة، وليس لها وجود حقيقي ذو طابع طوبوغرافي يحتل بقعة محسوسة في الأرض، هذا المختبر تملك الجماعة عبر تقنية روحية معينة مفتاح الدخول إليه، فالروح لها عوالمها واتصالها بالملك والملكوت، وهذا معتقد الجماعة والمؤلف السارد. “إنهم الآن شاخصون صامتون ومتوزعون في جنبات المختبر. هنا في هذا المكان الذي يجمع العالم تتقدس الأبدان وتتحرر الأرواح وتحفُّ السكينة، وبين وقت وآخر تخرج الشهقات والزفرات والأغاني والزغاريد. لا أحد يشعر بوجود الآخر، كل منهم يشعر بوجوده في المكان بمفرده. كانوا يأتون إلى هنا في أشد الظروف حلكة يجلسون في ذات الأماكن التي تعودوا عليها، ويسلمون على ذات الوجوده صاحبة المهابة، ويقبلون أيدى الأقران وجباه الكبار، يمكثون ساعتين أو أكثر في حال الصمت الكامل، وكلما تقدم بهم الوقت في عزلتهم البعيدة غرد طائر الصمت منهم وطار.” هكذا وصف “البحيري” “المختبر” حالة من التجريد مفتتحها الصمت وختامها الصمت، وبين الصمتين تغتسل الروح في ملكوتات الحرية السماوية. ولعل أيقونة “المختبر” و”المقام الشاذلي” الشريف هما اللذان حفزاني إلى اختيار عنوان الدراسة “الفضاء المتخيل وتجليات الهوية في البناء السردي.”
3- “المقام الشاذلي الشريف”
“في الشهر الثامن جاء موسم الحج إلى الصحراء” كانت الجماعة كل عام تقصد الصحراء هروبا من “ضيق النَّفَس ووجع القلب وتكلف المدينة، إلى الصحراء حيث الفضاء والمطلق. كانت المعرفة التي تكونت عند هؤلاء العابرين عن الصحراء من خلال العاكفين على صلاح الأرض الذين فروا من المكائد والظلم والجهل وخزي الإنسان. كانوا يقضون المواسم في تقصي أثر العابرين القدامى. فقط يتفقون فيما بينهم ويتركون الأمر لأحدهم يفصله كيفما شاء.” لتلك الجماعة دربة ودراية بطرق الخلاص الروحي نتيجة اقتفائهم لأثر العابرين والمسافرين القدامى. ابتدر “البحيري” حديثه عن الحج الموسمي بجملة أعدها جملة مركزية في الرواية “وهي في الشهر الثامن جاء موسم الحج” الشهر الثامن هو شهر ما قبل الولادة، فالثامن تبشر بميلاد جديد لهذه الجماعة، وأظنه الميلاد الحقيقي لها كما سيتضح لاحقا. الحج لغة “القصد” وهذا ما يتغياه “الروائي” من الحج تعريفه اللغوي، لأن تعريفه المصطلحي سيحدد ماهية الحج كشعيرة دينية تقتصر على المسلمين، ولكن الروائي نظرته أبعد من ذلك، فالفكرة الأساس في الرواية هي الإنسان بلا قيد ولا شرط ولا أيديولوجيا، والحج موجود في كل الديانات السماوية ولكل ديانة حجها، ولعلي من خلال مفردة “الصحراء” استحضر لاهوتية فكرة السياحة الأرضية التي خاض غمارها رهبان النصارى، وبعض متصوفة المسلمين، حتى وإن اختلف المعتقد ما بين راهب مسيحي، ومتصوف إسلامي، اتحدت الغاية الكبرى للسياحة وهي فكرة الخلاص الروحي والسعي وراء المطلق. وفي هذا الموسم تحديدا، جاء الدور على “عبدالله” فاختار الأيقون الروحي المتسيد بطريقته ورحلته العجيبة على سائر الطرق الصوفية، حتى قال عنه الأكابر:
ما من ولي في الورى … إلا تشذل كي يرى.
“ذاك النائم في وادي “حميثرا” بصحراء عيذاب، منذ أكثر من سبعة قرون ونصف لم يذهب إليه قبل اليوم. كان يعيش في حالة من الشوق لم تكتمل، يتوق بروحه إلى ذاك المكان على الرغم من عدم الوصول إليه مرة بالبدن.” كانت زيارة سيدي “أبي الحسن الشاذلي” رضي الله عنه وأرضاه- حدا فاصلا في تاريخ جماعة “خلية النحل”، فبعد شتاتهم المعرفي وتوزعهم ما بين العلم كنظرية والمعرفة كذوق، مع اعتقادهم الجازم بوجود عوالم وأطوار ترتقي وتتسامى على دائرة العقل المادي المرتهن بناموس الأسباب. هناك فقط حيث المشهد المقدس لسيدي ومولاي “أبي الحسن الشاذلي” ارتقت ذواتهم وحطت طيور البراري مناقيرها في أنهار من عسل ولبن مصفى سائغ للشاربين. “عبدالواسع” مجذوب الحضرة الشاذلية رفع الغشاوة عن العين؛ فأبصرت الحقيقة في مدارات الجلال. ذاك المجذوب الذي ساقته الأقدار؛ ليلتقي جماعة العابرين في المقام الشاذلي، مجيبا على كل الأسئلة التي تنازعتهم على مدى الأربعين المنصرمة من أعمارهم، وهم يسلكون الطريق سعيا للخلاص، وفي سيرهم نحو الكمال الروحي، والبهاء النوراني، تناوشتهم ذئاب الطريق، ومرغتهم الحيرة على عتبات المعرفة، حتى حل الموسم الثامن للحج، وفي “حميثرا” كشف الغطاء، وتجلت الحقيقة على عرش القلوب.
بعد تطوافنا على الأماكن التي تألفها الذات، بل لا يتحقق وجودها إلا فيها وبها، يتبين لنا ومما لا شك فيه، أن الفضاء المتخيل للذات الرائية هو الذي أعاد أدلجة هذه الأماكن واستظهار أيقونتها الروحية التي تنسرب منها إلى الذات العارفة، بل تدخلت الذات في إيجاد أماكن لا وجود لها على الإطلاق إلا في فضائها المتخيل كــ “دار الحارس” و “المختبر” ولكن عبر البنائية السردية العبقرية استطاع الروائي أن يخلق لهذين المكانين كيانا وجوديا متصلا بالواقع، حتى وإن اندحر الواقع تحت سلطة التخييل.
أما بالنسبة للأماكن المعادية التي تنفر منها الذات، ولا يتحقق وجودها فيها تمثلت في “نادي السهم” حيث اللقاء الأول الذي جمع بين جماعتي خلية النحل، وجماعة الخفاء”ذراع الصهيوماسونية العالمية” في مدينة النور “باريس” وانتهى اللقاء بهزيمة ساحقة لـ “جماعة الخفاء” على يد جماعة “خلية النحل”. “بيت الأفاعي” حيث اللقاء الثاني وأظنه ليس الأخير، وقد انهزمت فيه قوى الشر أمام جلال الروح المطلق في الإنسان. هذه الأماكن بلورت سيكولوجية العدو وغاياته وأهدافه، وسبله التي يسلكها من أجل تقييد المطلق ودحر جميع وسائل الخلاص.
– سيكولوجية الشخصية وتشكلها في الفضاء السردي:
يمثل مفهوم الشخصية عنصرا محوريا في البناء الروائي، فلا يمكن أن نتصور عملا روائيا دون شخصيات، “ومن ثم كان التشخيص هو محور التجربة الروائية.” ، وتنقسم الشخصيات الروائية وفقا لتناولها نظريا إلى [سيكولوجية- اجتماعية- وعاملية] فالنظرية السيكولوجية “تتخذ الشخصية جوهرا سيكولوجيا، وتصير فردا شخصا، أي ببساطة كائنا إنسانيا، وفي المنظور الاجتماعي تتحول الشخصية إلى نمط اجتماعي يعبر عن واقع طبقي، ويعكس وعيا أيديولوجيا. بخلاف ذلك لا يعامل التحليل البنيوي الشخصية باعتبارها جوهرا سيكولوجيا، ولا نمطا اجتماعيا، وإنما باعتبارها علامة يتشكل مدلولها من وحدة الأفعال التي تنجزها في سياق السرد وليس خارجه. إن التحليل البنيوي وهو يجرد الشخصية من جوهوها السيكولوجي ومرجعها الاجتماعي لا يتعامل مع الشخصية بوصفها “كائنا” أي شخصا، وإنما بوصفها فاعلا ينجز دورا أو وظيفة في الحكاية، أي بحسب ما تعمله، ومن ثم يستبدل “غريماس” مفهوم الشخصيات بمفهوم العوامل” ولكن ثمة روايات تتعالى على التحليل البنيوي، نظرا، لذاتية الرواية وجنوحها نحو فضائها المرجعي المتخيل، كـ رواية “خلية النحل” للروائي “أحمد البحيري” حيث يعلو صوت الذات، ويتجلى وعيها في أفق البناء السردي.
فالشخصيات في رواية “خلية النحل” تتأبى على بنيوية التحليل، وتجنح نحو النظريات السيكولوجية التي تنظر إلى الشخصية باعتبارها جوهرا نفسيا يتجلى في البناء السردي مهيمنا على كيان الرواية بسلطة الهوية ورؤية الذات للعالم.
تتوزع الشخصيات في الرواية على محورين: الأول، الشخصيات التي تمثل وجهة نظر الذات المبدعة، الساعية للخلاص الروحي عبر تجربة التصوف، وهذه الشخصيات هي [الحارس، عبدالله، مريم، سلمى، رندا، أوديت، الحايك، عمار، نجيب، جو، جورج، الجهم، ابن الرماح] وبمطالعة الأسماء يتبين للقارئ أن ثمة رباطا مقدسا يربط هذه الأرواح المختلفة ظاهريا من حيث الديانة والمعتقد والتاريخ، ولكنها تسامت على كل هذه الموانع بالمحبة، حيث الحب هو بغيتها وسبيلها للخلاص وتقبل الآخر؛ لتتجلى الإنسانية أو “وردة الأشواق” في أبهى صورها. ولم يكتف “البحيري” بذلك ولكنه استدعى شخصيات تاريخية متناحرة في الرؤى والمعتقد، وجعلها منسجمة في روايته أيما انسجام، فقد استدعى “الجهم” و “ابن الرماح” فالجهم هو: “الجهم بن صفوان” من “المعطلة” الذين شذت أقوالهم عن القاعدة من وجهة نظر السلف آنذاك، وقتل وهو يدافع عن وجهة نظره تلك. و”ابن الرماح” هو: أبو محمد، عبدالله بن عمر بن الرماح البلخي ثم النيسابوري، كان صاحب سنة، وصدع بالحق، وامتنع عن القول بخلق القرآن، وكفر الجهمية. هكذا ورد ذكره في “سير أعلام النبلاء” ومع هذا الاختلاف العقدي، استدعى “البحيري” هاتين الشخصيتين في سياق زمني مغاير، وإطار مكاني مختلف، ومن ثم توافقا بعد اختلاف، والتقيا بعد فرقة في رواية “خلية النحل”. ولم يكتف “البحيري” بهذا وحسب، ولكنه كان يختار من أعلام التاريخ الأسماء الملبسة، والأعلام التي تكرر ذكرها في أزمنة تاريخية مختلفة، ليحمل الاسم أكثر من مدلول، ويدل على أكثر من ذات، مع احتمالية التعددية لهذا الاسم، فـ “ابن الرماح” كعلم تكرر ذكره في التاريخ ثلاث مرات، فهو، قاضي نيسابور الذي كفر الجهمية، وكانت وفاته في ذي القعدة 234 ه. و”ابن الرماح” المقرئ النحوي من أكابر القراء ومشاهيرهم، وأعيان النحاة وأفاضلهم في القرن السابع الهجري، ولم يصلنا شيء من تراثه إلا تسع مسائل حفظها السيوطي في كتابه “الأشباه والنظائر” نقلا عن تذكرة “ابن الصائغ”. و”ابن الرماح” أو “حسن الرماح” المتوفى 1294ه، كميائي ومهندس مملوكي عربي، عرف بـ “حسن الرماح” لمهارته في رمي الرمح، وكان رائدا في تصنيع الأسلحة في زمانه، وله العديد من الكتب والرسائل في المكائد والأسلحة الحربية منها: (كتاب الفروسية والمناصب الحربية، كتاب البنود في معرفة الفروسية، كتاب الفروسية في رسم الجهاد) وهذا الأخير توجد مخطوطته الأصلية في باريس تحت رقم[ 2825] وبهذه المخطوطة إشارات كاملة عن تصنيع البارود وهيئته وكيفية تركيبه. فأي واحد من الثلاثة يقصده الروائي الماكر “أحمد البحيري” فذكر “ابن الرماح” في متن حكائي “الجهم” أحد شخصياته يفرض عليك أن تختار “ابن الرماح” الذي كفر الجهمية. ولكن اعتياد “ابن الرماح” في رواية “خلية النحل” أن يمسك “مطواة” دائما لا تفارقه ولا يمشي إلا بها، تفرض عليك أن تتأوله بـ “حسن الرماح” الكميائي المهندس الماهر في تصنيع البارود، والتي استلبت فرنسا مخطوطته الحربية الهامة جدا، وهكذا تتجلى عبقرية الروائي وهو يقلبك على أكف التأويل تتنازعك الحيرة ويعتريك الشك، وعزاؤنا الوحيد أن الرواية الكبيرة حقا هي التي تتأبى على التأويل السحطي، والقراءة الواحدة.
في نسق سردي عجيب استطاع “البحيري” أن يركب كياناته الشخصية وفق منظوره النفسي، ومرجعيته الفكرية، وتجربته الصوفية الجادة، فجعل من تلك الشخصيات كيانا واحدا متعاليا على التفتيت، وكأن كل شخصية من هذه الشخصيات تمثل نازعا من نوازعه وميوله النفسية التي ارتقت بتجربتها الروحية.
“إن الرواية الحديثة أقل ادعاءً من شقيقتها القديمة، ولذلك فهي أقل زيفًا.. إنها لا تعكس حقائق صارمة، بل تخلق حقائقها. وليست وظفيتها تسجيل مغامرة محض، وإنما القيام بمغامرتها الخاصة، وعند ذاك فقط تستطيع أن تلمس لغز الوجود من موضع آخر لم يلمسه أحد قبلا، ويدخل في منطقة عذراء لم ينتهكها أحد في ما مضى. وكبار الروائيين أفلحوا في إدهاشنا مرارا لأنهم استدرجونا بطريقة مغايرة، وإلى مكان آخر من العالم، أو داخل أنفسنا. إن الرواية الكبيرة هي تلك التي تلقي في دواخلنا شيئا من الأسى على التجربة الإنسانية، وشيئا من فرح الحياة، وتثير فينا رعشة الوجود.” وهكذا فعل بنا الروائي الكبير الأستاذ “أحمد البحيري”.
 الخبر الثقافي موقع يهتم بكافة النواحي الثقاقية بمختلف مجالاتها وتغطية الأخبار الفنية .
الخبر الثقافي موقع يهتم بكافة النواحي الثقاقية بمختلف مجالاتها وتغطية الأخبار الفنية .